الأزمة اليمنية..أسبابها وجذورها وبواعثها المحلية والإقليمية
- محمد القيرعي السبت , 30 يـنـاير , 2021 الساعة 6:31:21 PM
- 0 تعليقات

محمد القيرعي / لا ميديا -
إن أسوأ ما يشوب مسارات محنتنا الوطنية الراهنة اليوم يكمن وبشكل أساسي في ذلك التغييب والتجاهل العمدي لمجمل الحقائق المتصلة بها، من قبل مجمل القوى والنخب السياسية والحركية والإعلامية والثقافية والأكاديمية في الداخل والخارج على السواء.
ولا أقصد هنا فحسب تلك الحقائق المغيبة والمتصلة بجرائم الحرب والعدوان والحصار البربري الذي يقترب من عامه السابع والذي تشنه دول التحالف الانبطاحي العربي بقيادة السعودية وبإسناد لوجستي مفتوح ومباشر من قبل إمبراطورية اليانكي (أمريكا) بكل ما خلفه هذا العدوان من جرائم قتل جماعي ممنهج لنساء وأطفال وشيوخ ورجالات شعبنا اليمني ومن دمار كلي استئصالي لكل أسس ومقومات الحياة الآمنة والمستقرة عبر الاستهداف الممنهج للبنى التحتية الأساسية لحياة شعبنا، وإنما أيضا تلك الحقائق المتصلة بأسباب وتداعيات الأزمة ذاتها، والتي حرص الجميع تقريبا منذ البداية بمن فيهم مثقفي وسياسيي الداخل الوطني على وأدها وتغييبها، مفسحين بذلك المجال لسيادة ذلك الخطاب السياسي والدعائي الانهزامي والتضليلي الذي كرست له قوى العدوان ونظام هادي الأضحوكة الكثير من الإمكانيات المادية واللوجستية لجعله من الحقائق المسلم بها في صياغة المشهدين السياسي والوطني، على أساس شرعية هادي التقدمية والمعترف بها دوليا وانقلابية "الحوثيين" الماضوية، وتصوير جرائم الجماعات الدينية والتكفيرية والانفصالية على أنها نضال وطني وتقدمي مقدس، والاحتلال السعودي الإماراتي لأجزاء واسعة من بلادنا بمشاريعه الانقسامية والتفكيكية على أنه سد عربي منيع أمام الأطماع الفارسية المزعومة على كل حال والتي لم يتسن لنا التعرف عليها إلا عبر قراءتنا لكتب التاريخ المدرسي وليس على أرض الواقع كما يروج له منظرو الحرب وأدواتها.
ولكي نفهم بشكل واعٍ وموضوعي الجذور الأولى لنشوب الحرب الراهنة، دعونا نستذكر في البدء تلك الصرخة المذعورة التي صدرت عن القيصر الروسي (نيقولاي الأول) حينما نما إلى علمه نبأ نجاح "كومونة باريس" الثورة الشعبية الشيوعية الأولى في العام 1871، وبما معناه: "ركبوا الشروط أيها الضباط فقد اندلعت الثورة في فرنسا"، موجها من خلالها ضباطه وقادة جيشه باتخاذ التدابير الكافية لمنع انتقال عدوى الثورة الشعبية الفرنسية إلى روسيا القيصرية.
كانت الصرخة نفسها قد صدرت بعد ذلك بحوالي 143 عاما في صنعاء، وبالتحديد في الثلث الأخير من العام 2014، من قبل تحالف أعداء الشعب (نظام هادي- باسندوة- المشترك) الذين أعقبوا نظام حكم الرئيس علي عبدالله صالح المطاح به أواخر العام 2011 عبر ثورة شبابية وشعبية عارمة كانت من أبرز انتكاساتها ونتائجها الكارثية وصول تلك الطغمة المنفلتة إلى الحكم والتي قدمت بطبيعة الحال أسوأ نماذج العمالة الخارجية والحكم القمعي واللصوصي بصورة أسفر عنها وبشكل سريع ليس فحسب إيصال علاقاتهم مع أصحاب الثورة الحقيقية تحالف القوى الشبابية والاجتماعية إلى حالة الطلاق الفعلي، وإنما أيضاً تمهيد الطريق وجعلها سالكة تماما لوصول "الحوثيين" إلى السلطة مسنودين بحالة من الدعم والإسناد الشعبي والجماهيري العارم وليس على ظهور الدبابات الانقلابية كما يدعي الآخرون.
بيد أن هذا الدعم والإسناد الشعبي الذي حظوا به آنذاك من قبل أوسع قطاعات المجتمع اليمني التي نظرت لـ"الحوثيين" آنذاك بوصفهم الوريث الفعلي لمجمل أطراف منظومة العمل الحزبي والسياسي والحركي التقليدية والفاسدة، لم يقتصر فحسب على استيلاء "الحوثيين" على السلطة الفعلية في 21 أيلول/ سبتمبر 2014 بقدر ما شمل أيضا قبل ذلك معارك "الحوثيين" المتفرقة بدءا من دماج وصولا إلى عمران وصنعاء والتي استهدفت اجتثاث جذور الدولة المتسلطة العميقة لأسرة الأحمر، أو لنقل لتحالف اليمين الديني والعشائري والعسكرتاري المكون من أسرة عبدالله الأحمر ومن حزب الإصلاح وجناحهم العسكري في الجيش بقيادة جنرال الخطيئة علي محسن الأحمر.
إن مما لا شك فيه هو أن الانتفاضة الشعبية التي شهدتها بلادنا في أيلول/ سبتمبر 2014 والتي مهدت الطريق فعليا لثورة الواحد والعشرين من أيلول/ سبتمبر تعتبر حدثا استثنائيا، وذلك بغض النظر عن كل ما قيل بشأنها.
في الواقع، شهدت تلك السنة من تاريخنا الوطني الإطاحة بمنظومة الحكم اللصوصي لنظام (هادي- باسندوة- أحزاب اللقاء المشترك) ثم التمهيد فعليا لوصول "الحوثيين" إلى سدة السلطة السياسية مسنودين بحالة من الدعم والإسناد الشعبي والجماهيري العارمة، بما أفرزته تلك العملية الثورية (الثورة الشبابية) من ظهور سلسلة من المؤامرات، وانتشار العنف، فضلا عن تنامي مشاعر الولاء، والغدر، والخيانة والتآمر والشجاعة والعمالة الخارجية بالصورة التي لا يسعنا من خلالها إلا أن نحاول أن نتبين الفهم السائد لهذه الأحداث بالغة الأهمية التي هزّت بلادنا مذاك.
فاللافت أن فشل الثورة الشبابية الشعبية 2011 لم يقتل جوهر تلك الهبة الأيديولوجية الشعبية بقدر ما أنتج قدرا آخر من الجدلية الثورية تمخضت عما يمكن أن نسميه مجازا امتدادا ثوريا للتطلعات الشعبية التي توجت بانتصار ثوار 21 أيلول/ سبتمبر 2014، وإقصاء النخب السياسية التقليدية العتيقة (أحزاب اللقاء المشترك) والتي وعلى الرغم من انخراطها في حوار وطني معلن مع "الحوثيين" في الثلاثة الأشهر اللاحقة على الأقل، وبالتحديد خلال الفترة من أكتوبر 2014 إلى فبراير 2015 (حوار موفنبيك) لتقرير مسار العملية السياسية في البلاد، إلا أن تلك النخب السياسية التقليدية العتيقة نجحت وعبر الاستغلال الانتهازي لمعمعة الحوار ولتخبط "الحوثيين" في حلقاتها جراء افتقارهم على ما يبدو لحنكة العمل السياسي، نجحت في بذر بذور الفتنة الوطنية الراهنة وغرس جذور محنة الحرب والاحتلال عبر محاولتهم الاقتلاعية منذ البداية ليس فحسب في وأد الثورة في قبرها والاحتفال بدفنها، وإنما أيضا من خلال إيغالهم الانهزامي في التأسيس لسلسلة من العوامل الكامنة، مثل توظيف صرخة "الحوثيين" بغية جر التدخلات الخارجية المتحالفة التي تقف وراء هذا الانحطاط وتلك المذابح التي ارتكبت ولا تزال ترتكب حتى اللحظة في حق شعبنا وبلادنا بذريعة الدفاع عن "الشرعية" انطلاقا في المقام الأول من وضاعة وانتهازية الخطاب السياسي والأيديولوجي الذي تبناه أعداء الشعب والذي جاء متناغما بطبيعة الحال وبشكل صارخ مع الادعاء الزائف الذي تتبناه الأنظمة المتصلبة والاستبدادية في الجوار، التي تدّعي أنها تمثل كيانا أرقى بكثير من الثورة.
وفي خضم هذه التطورات الدراماتيكية بادرت الحكومات المتورطة في الحرب إلى تخويف وإرهاب المثقفين والكتَّاب، من أجل مواصلة نهجها العسكري لتدمير البلاد والعباد
يتضح لنا مما سبق أن جذور وبواعث الأزمة السياسية الراهنة بدأت بالتبلور الفعلي عقب الإطاحة بنظام صالح في 2011، وتبوؤ الأفندم عبد ربه منصور هادي مقاليد السلطة السياسية بالتحالف مع منظومة أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة سابقا لنظام صالح) والتي هيمنت عقب الإطاحة به على حكومة (باسندوة ـ هادي) خلال الأعوام الثلاثة اللاحقة (2011 ـ 2014) في تجربة سياسية بدا واضحا منذ البداية أنها لم تكن كـ"منظومة سياسية ـ حزبية" جاهزة لها أو مهيئة عمليا للحكم، ليس فحسب جراء افتقارها الفعلي إلى مشروع ورؤية وبرنامج وطني إصلاحي واضح لإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية الحرجة والانتقال السلس والمفترض بالبلاد والسلطة صوب تعميق الحياة المدنية والديمقراطية ومكافحة الفوضى والفساد والمحسوبية... الخ، وإنما أيضا جراء إخفاقه الفعلي (كتكتل سياسي وحركي عريض) في تنظيم المجتمع تنظيما سياسيا وثوريا وفي تلبية تطلعاته المتعددة..
وهذا ناجم بالأساس عن مظاهر الانقسام العميقة التي كانت ولا تزال تشوب مواقف وسياسات أغلب أطراف هذا التكتل (أحزاب اللقاء المشترك) المشكل في الأساس من خليط متنافر وغير منسجم أصلا في بنيانه الحركي، لا من حيث الطبيعة الأيديولوجية ولا من حيث الاتجاهات الفكرية والسياسية، حيث جمع في بنيانه الهش أحزاباً من أقصى اليسار ومن اليسار السياسي عموما مثل الاشتراكيين والقوميين باتجاهاتهم المختلفة (ناصريين وبعثيين) بالإضافة إلى تحالف أحزاب اليمين الديني والعشائري ممثلة بالإخوان المسلمين، بالإضافة إلى الأحزاب الدينية الأخرى ذات الاتجاهات السلالية والمذهبية، على شاكلة حزبي الحق واتحاد القوى الشعبية، اللذين كانا يشكلان آنذاك عماد القوى الشيعية، قبل تنامي نفوذ حركة أنصار الله "الحوثية".
وإجمالاً نستطيع القول إن تجربة حكم (هادي ـ المشترك) شكلت انتكاسة وطنية وثورية مريعة، حيث أخفق هذا التحالف (أحزاب اللقاء المشترك) في إنشاء برنامجه السياسي والمدني والديمقراطي والتنموي، مثلما أخفق أيضا في تنظيم وتعميق تحالفاته المفترضة مع القوى والطبقات الشعبية الأخرى، على غرار التجربة الانتقالية والديمقراطية الفريدة التي حققها نهاية سبعينيات القرن العشرين "تكتل أحزاب الوحدة الشعبية" في جمهورية تشيلي في أمريكا اللاتينية والذي يتشابه من حيث الفكرة والجوهر والطبيعة الأيديولوجية المتعددة لأطرافه مع تحالف اللقاء المشترك في بلادنا، والذي نجح قادته، أي الوحدة الشعبية، في لم شتات وتوحيد مجمل القوى السياسية والطبقية والعمالية وحتى الدينية أيضا محققين من خلالهم نصرا ساحقا على الديكتاتورية في تشيلي، وذلك على عكس تجربة تكتل أحزاب اللقاء المشترك، التي وعلى الرغم من أنها كانت تشكل في عهد صالح -كما أشرنا سلفا- عماد المعارضة السياسية والحركية والأيديولوجية الظاهرة كما هو مفترض لحكمه رغم أدائها الضعيف وعديم الفاعلية الناجم بدرجة أساسية من كون أطرافها وتنظيماتها مكونة كما أسلفنا من مجموعات حزبية ومن حلقات سياسية مجزأة ومنفصلة بعضها عن بعض ومتنافرة إن جاز التعبير، بسبب التناقض الفكري والأيديولوجي الحاد المعشعش بين مختلف مكوناته، الأمر الذي كان من نتائجه المباشرة سلسلة متتالية من العثرات والنكبات المتلاحقة جراء الفوضى والفساد والمحسوبية وسوء الإدارة الذي جسدوه بصورة أسوأ بكثير مما كان عليه في عهد الرئيس المطاح به علي عبدالله صالح، ممهدين الطريق بذلك لانتقال البلاد إلى الطور الثاني والمعقد من الأزمة السياسية، ومفسحين المجال لـ"استيلاء الحوثيين" على السلطة السياسية في سبتمبر 2014 بالصورة التي سنشرح أسبابها وتداعياتها لاحقا.
فحركة الاحتجاج الشبابية والجماهير الشعبية الواسعة أطاحت العام 2011 بنظام حكم صالح (ذي النزعة الديكتاتورية والاستحواذية المبطنة)، إلا أنها ومن الناحية الأخرى قد شكلت منعطفا حيويا وحرجا في مسار تطور العملية السياسية والمدنية في البلد.
فمن الناحية الموضوعية كانت حركة الجماهير تسحق النظام القديم (نظام صالح) وتمهد السبيل أمام تغيير الطبيعة الدولاتية للحكم وتأسيس مناخ مدني وديمقراطي جديد، فيما منظومة الحكم الجديدة كانت أكثر فسادا وفوضوية من نظام صالح المطاح به، الأمر الذي مهد الطريق تماماً لانقضاض "الحوثيين" على السلطة في سبتمبر 2014، مسنودين بدعم شعبي وجماهيري واسع النطاق، وبجملة كاملة من الأسباب والعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية (داخليا وخارجيا)، وليس نتاج انقلاب عسكري كما يصوره خصومهم.
إذ يمكن القول بأن "استيلاء الحوثيين" على سلطة الرئيس هادي في سبتمبر 2014، كان في المقام الأول نتاجاً لإخفاق نظام (هادي ـ حكومة باسندوة ـ المشترك) ليس فقط في الإدارة العامة للبلاد وفي تلبية التطلعات الشبابية الجارفة في مكافحة الفوضى والفساد والمحسوبية، وإنما أيضا في الاهتمام بجرحى وبأسر قتلى وضحايا الاحتجاجات الشبابية الذين جوبهوا من قبل النظام الجديد (نظام هادي المتحالف مع تكتل تحزاب اللقاء المشترك) بردود أمنية وقمعية كانت سببا رئيسيا ومباشرا في نشوب أزمة ثقة شائكة تغلغلت سريعا وبشكل كارثي في علاقة أغلبية القوى الجماهيرية والشعبية المرهقة بنخبة الحكم الجديدة والواصلة أساساً على أكتاف ثورة الشباب في فبراير 2011
وقفنا سابقاً عند أسباب انعدام الثقة الكلي الذي استفحل ما بين أغلب القوى الجماهيرية والشعبية من جهة وبين منظومة الحكم الجديدة المكونة من التحالف المافيوي المشكل من هادي وحكومة باسندوة كمحاصصة بين أطراف تكتل أحزاب المشترك، الأمر الذي مهد الطريق بقوة لاستيلاء "الحوثيين" على السلطة في سبتمبر 2014، مسنودين كما أسلفنا بدعم شعبي وجماهيري واسع وبجملة كاملة من الأسباب التي خلقت لدى الشارع الجماهيري اعتقادا راسخا بأن حركة أنصار الله (الحوثيين) قد يكونون هم الورثة الفعليين لكامل أطراف الحركة الوطنية، وهو الاعتقاد الذي شمل حينها قطاعات واسعة ومؤثرة في الجيش والمؤسسات الأمنية الذين ساندوا بشكل أو بآخر تقدم "الحوثيين" صوب العاصمة صنعاء ثم "إسقاطها" في سبتمبر 2014 بصورة يمكن تشبيهها بـ"الحالة الاجتماعية الثّوريّة" التي تنشأ عادة وفي أي مجتمع حين ترفض الجماهير الشّعبيّة المحكومة العيش في ظلّ النّظام القائم بمؤسّساته القديمة، وحين تعجز الطّبقات الحاكمة ذاتها عن إدارة الشؤون العامة للبلاد وعن كسب ثقة وتعاطف الشارع الشعبي.
فكانت الجرعة الاقتصادية الحادة التي أقرتها حكومة (باسندوة- المشترك) والمتثملة بفرض زيادة بواقع 100% على كل المواد والسلع الأساسية والاستهلاكية في منتصف العام 2014 هي القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث خرجت الجموع الشعبية وفي مختلف محافظات البلاد في موجة عارمة من التظاهرات والاحتجاجات التي توجت باستيلاء "الحوثيين" على السلطة في سبتمبر 2014، مسنودين بحالة الزخم الشعبي العارمة تلك والناشبة على ضوء إقرار حكومة (باسندوة- المشترك) للجرعة الاقتصادية غير المبررة أصلا، بالإضافة إلى أن الشعور بالمظلومية التاريخية المشتركة كان الجامع والموحد الأساسي لجماعة "الحوثيين" بالجموع الشعبية الغاضبة والمحبطة والمخدوعة على امتداد المشهد الوطني إن جاز التعبير.
الظروف السياسية والاجتماعية التاريخية المحيطة بتطور حركة "الحوثيين" وتفوقها اللوجستي والعسكري
عانى "الحوثيون" قبل استيلائهم الكامل على السلطة من عقد كامل من الحروب المتقطعة التي شكلت في مجملها ست حروب، خمس منها شنت من قبل نظام صالح المطاح به، والحرب السادسة والأخيرة شنت من قبل نظام (هادي- تحالف المشترك) المهيمن عليه من قبل حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) خلال عامي (2013-2014)، وانتهت بسقوط تحالف (الرئيس هادي- المشترك) واستيلاء "الحوثيين" على السلطة بشكل نهائي.
كانت أولى هذه الحروب التي شنت ضد جماعة "الحوثيين" قد نشبت في يونيو 2004، من قبل نظام صالح، وانتهت بمقتل أول مؤسس لتنظيم الشباب المؤمن آنذاك (حركة أنصار الله حاليا) الداعية حسين بدر الدين الحوثي في حوالي أغسطس عام 2004، وهو الشقيق الأكبر لقائد الحركة الحالي السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، لتتوالى بعدها حروب السلطة ضد "الحوثيين" وإن بشكل متقطع بعد أن تولى عبدالملك الحوثي قيادتهم بصورة لا تزال قائمة حتى اليوم، بيد أن حروب صالح التي توالت من العام 2004 وحتى إسقاط نظامه في 2011 ظلت مبهمة النتائج خلال أغلب مراحلها، بحيث لم تزد سيطرة وتواجد "الحوثيين" خلالها كحركة عن نطاق محافظة صعدة المحاذية للسعودية، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن النظام الملكي السعودي كانت له إسهاماته العدائية الحربية ضد "الحوثيين" بواسطة طائراته الحربية التي أسهمت بجهد حربي مشترك خلال بعض جولات الحروب الخمس السابقة مدفوعة بمخاوف السعوديين من أن تنامي نفوذ وقوة "الحوثيين" على تخوم حدودهم الجنوبية يشكل تهديدا خطيراً على أمنهم القومي وعلى سلامة نظامهم السياسي بسبب تبعية "الحوثيين" الفكرية والمذهبية لمنافس السعودية وخصمهم التقليدي جمهورية إيران الإسلامية، رغم أن نتائج التدخل العسكري السعودي في أغلب جولات الحرب السابقة كانت قد أسفر عنها بشكل جوهري ومباشر ليس فحسب تقوية شوكة "الحوثيين" وزيادة رقعة نفوذهم، وإنما أيضا تنامي تعاطف الشارع الشعبي معهم على امتداد الجغرافيا الوطنية.
وحينما نشبت الثورة الشبابية ضد نظام صالح في فبراير 2011 كان لـ"الحوثيين" حضورهم الاحتجاجي الملفت أيضا بطبيعته السلمية في ساحات الاعتصام الرئيسية وخصوصا في العاصمة صنعاء، وحينما تدخلت دول الجوار ممثلة بالسعودية ودول الخليج ومجلس الأمن الدولي في الأزمة اليمنية ليتم على ضوء هذا التدخل إقرار المبادرة الخليجية التي تمخضت عن عقد مؤتمر حوار وطني شامل بدأت أعماله في الانعقاد في مارس 2013، والذي كان من أهم المهام المفترض به إنجازها إقرار شكل الدولة الجديدة ودستورها وعلاقات كيانات البلد وأقاليمه المختلفة وقواه الاجتماعية وهيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية المنقسمة والمتعددة الولاءات ما بين نظام صالح القديم ونظام هادي الجديد، بالإضافة إلى وضع حلول ديمقراطية منصفة لأغلب المشكلات الاجتماعية والوطنية الشائكة والمعقدة مثل القضية الجنوبية وقضية صعدة التي تخص بشكل أساسي ومباشر مظالم "الحوثيين" بما تمخضت عنه نتائج جولات الحروب الست المعلنة ضدهم من قبل نظام صالح وهادي من بعده.
كان التدخل الخليجي عبر المبادرة المشؤومة (المبادرة الخليجية) المسنودة بمباركة أممية، وهي المبادرة التي تم تعظيمها والتهليل لها ظاهريا بكونها المخرج الوحيد لشعبنا وبلادنا من عنق الزجاجة، فيما الحقيقة كانت مغايرة كليا لما يتم الإعداد له في أروقة ودهاليز مؤتمر الحوار الوطني والذي هدف من وراء عقده في الأساس ليس فحسب ضمان إبقاء بلادنا خاضعة لبيت الطاعة السعودي والأمريكي، وإنما التمهيد لتجزئتها عبر جملة من المشاريع السياسية والإجرائية الجاهزة التي حلت فيها أفكار إقرار النظام والقومية المتطرفة محل أفكار الديمقراطية. بالنظر إلى نتائج أعمال مؤتمر الحوار الوطني الذي دام خلال الفترة (مارس 2013- يناير 2014) لم تكن موفقة بالمطلق في حل أي من تلك القضايا والمعضلات، رغم تبني الأمم المتحدة كافة أعمال المؤتمر بشكل رئيسي من خلال الدعم الذي قدمته المنظمة الدولية بمستوياته الدبلوماسية والسياسية والتقنية واللوجستية والمالية، بالإضافة إلى الفرق المتوالية من الخبراء في العمليات الانتقالية والحوارات الوطنية وصياغة الدستور والقانون والحكم، والتخطيط لها بطريقة متعمدة ومدروسة ومستنيرة، والتعلم من تجارب الدول الأخرى.
مثلما عملت الأمم المتحدة قبل ذلك ممثلة بموفدها إلى اليمن آنذاك جمال بن عمر بشكل وثيق مع مختلف الأحزاب والقيادات السياسية اليمنية للترتيب لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. وبدأت اللجنة التحضيرية الفنية اجتماعاتها بإشراف أممي مباشر في يونيو 2012، بشراكة جميع الفصائل السياسية والدوائر الانتخابية، لتختتم أعمالها في ديسمبر 2012 بالاتفاق على الهيكل والتنظيم والقواعد الإجرائية وإدارة مؤتمر الحوار الوطني. وشمل ذلك إنشاء أمانة ورئاسة للإشراف على تسع مجموعات عمل تناولت قضية الجنوب، وقضية صعدة، والقضايا الوطنية، والمصالحة والعدالة الانتقالية، وبناء الدولة، والحكم الرشيد، وأسس بناء الجيش والأمن، والكيانات المستقلة، والحقوق والحريات، والتنمية المستدامة.
كما ساعدت الأمم المتحدة أيضا في تعزيز إنشاء أمانة الحوار الوطني في وقت قياسي، من خلال توفير الخبرات والأموال والدعم السوقي، تحت قيادة الرئيس هادي. وقد شارك 565 مندوبا في مؤتمر الحوار الوطني الشامل يمثلون جميع الدوائر الانتخابية اليمنية، بما في ذلك مجموعات من الحراك الجنوبي و"الحوثيين"، بالإضافة إلى النساء اللواتي حصلن على ما يقرب من 28 من مقاعد المؤتمر، وكذلك مقاعد للشباب والمجتمع المدني (باستثناء المهمشين طبعا الذين تم إقصاؤهم وتغييبهم عمدا بتواطؤ كافة القوى السياسية والمدنية)
في مؤتمر الحوار الوطني، الذي بدأت جلسات انعقاده رسمياً في 18 مارس 2013، لتنتهي في 24 يناير 2014، بإشراف الأمم المتحدة التي سهلت عشرات جلسات الحوار، بناء على طلب من المتحاورين، قُدمت عشرات الأوراق التي تعكس تجارب البلدان الأخرى في مختلف المسائل، مثل المسألة الجنوبية التي نالت الحيز الأهم من جلسات المؤتمر، رغم أن الفريق العامل المعني بهذه القضية وصل في نهاية المطاف إلى طريق مسدود، ليتم على إثرها تشكيل لجنة فرعية.
كما سهلت الأمم المتحدة اجتماعاتها لمدة ثلاثة أشهر، قادت في 23 ديسمبر 2013 لتوقيع الاتفاق على حل القضية الجنوبية على أساس الفيدرالية وبصورة لم تكن عادلة أو مرضية البتة لكافة أبناء المحافظات والأقاليم الشمالية التي يشكل تعدادها السكاني 75% من التعداد الوطني.
وهو الوضع أو النتائج ذاتها التي انطبقت على قضية صعدة أو "الحوثيين" الذين حضروا في إقليم مقترح يسمى إقليم آزال بصورة كانت كافية في حال تطبيقها عملياً لتجريدهم من كل مقومات النماء القابلة للحياة والتطور.
وقد اختتم مؤتمر الحوار الوطني الشامل أعماله في 25 يناير 2014 باعتماد وثيقة النتائج التي نصت على خارطة طريق نحو الانتقال الكامل باليمن إلى دولة تدعم الديمقراطية والحرية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد. اتفقت لجنة خاصة في وقت لاحق على أن تتكون الدولة الفيدرالية الجديدة من ست مناطق أو أقاليم.
وفي الإجمال نستطيع القول بأن جهود ونتائج أعمال مؤتمر الحوار الوطني التي دامت لما يربو على التسعة أشهر، ورغم الدعم الأممي الواسع الذي حظي به إلا، أن التدخل السعودي بشكل خاص وهم العدو التقليدي لـ"الحوثيين"، وكذا التدخل الخليجي عموما في رسم وتقرير نتائج أعمال المؤتمر، كان له أثره الكارثي في فشل المؤتمر وفي تعقيد الأزمات الوطنية الرئيسية وبالأخص القضية الجنوبية وقضية صعدة، بصورة أدت في نهاية المطاف إلى انهيار الوضع والنظام السياسي، الذي استغله "الحوثيون" باحتراف مذهل ليستولوا من خلاله على السلطة بعد أقل من ثمانية أشهر على اختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
أسباب استيلاء "الحوثيين" على السلطة
إن التعقيدات التاريخية الراسخة في بنية المشهد الوطني اليمني بتوازناته المختلة على الدوام على الصعد السياسي والعسكري والاجتماعي والقبلي، ظلت ولا تزال تشكل على مدى عقود زمنية طويلة وماضية واحدة من أبرز حجرات العثرة الماثلة أمام إمكانية نموه واستقراره وتطوره الحضاري والمدني والديمقراطي، ما جعل من أي حوار حضاري أو اتفاقيات مبرمة بين قواه المتصارعة والمتنافسة والمؤثرة أمرا غير فعال أو مُجدٍ كما يلاحظ على مدى العقود الستة الفائتة على الأقل منذ الإطاحة بالنظام الأمامي الملكي، وإقامة الجمهورية في سبتمبر 1962.
ولنختصر مقارناتنا في هذا السياق بأحداث العقود الثلاثة الفائتة على الأقل.
فمثلما كانت اتفاقية "العهد والاتفاق" الموقعة في الأردن في العشرين من فبراير 1994 بين طرفي الوحدة آنذاك (الحزب الاشتراكي اليمني بقيادة نائب الرئيس علي البيض، والمؤتمر الشعبي وحليفه الإصلاح بقيادة الرئيس صالح)، فمثلما كانت سببا رئيسيا لنشوب الحرب الأهلية بين شمال اليمن وجنوبه عقب توقيع الوثيقة بأقل من شهرين فقط، لتنتهي تلك الحرب الشطرية في يوليو من العام ذاته 1994 بهزيمة الجنوب واحتلال القوات الشمالية لمجمل أراضيه...
كذلك انتهت مخرجات ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل باجتياح "الحوثيين" للعاصمة صنعاء بعد أقل من ثمانية أشهر فقط على اختتامها، وفرض حضورهم السياسي والعسكري كأمر واقع، ليتم على ضوئها توقيع اتفاق "السلم والشراكة" برعاية الأمم المتحدة عبر موفدها الدائم آنذاك جمال بن عمر. وقد منح الاتفاق "الحوثيين" شراكة لوجستية في الحكم بواقع سبع حقائب وزارية، لينتهي الاتفاق ذاته باستيلاء "الحوثيين" بصورة كلية ونهائية على السلطة، ثم مباشرتهم بعقد المؤتمر الوطني الموسع في العاصمة صنعاء في الثلاثين من يناير 2015، والذي كنت أنا شخصيا مشاركا رئيسيا في أعماله بصفتي مندوبا ممثلا لمحافظة تعز ونائبا لرئيس لجنة صياغة قرارات ومقررات المؤتمر الذي انتهت أعماله بإعلان مسودة الإعلان الدستوري الذي عطلنا من خلاله العمل بالدستور وألغينا دور وكيان المؤسسة التشريعية (البرلمان) في خطوة إجرائية تزامنت في الوقت ذاته مع تمدد "الحوثيين" في بقية المدن والمحافظات اليمنية، وهو ما وجدت فيه السعودية مبررا للتدخل عسكريا عبر تحالف عربي ودولي بقيادتها لكبح جماح "الحوثيين" وإعادة "الشرعية"، كما أشيع حينها، بما تسمى "عاصفة الحزم" في 26 مارس 2015.
كانت من جملة أسباب انتصار "الحوثيين" المذهل والسريع والمتمثل في استيلائهم على السلطة في سبتمبر 2014، ما يلي:
1 - نجاحهم في استغلال حالة الضعف الذاتي والمتأصل في مختلف أطراف الحركة السياسية الوطنية التي كانت تعيش حالة من الاسترخاء وشبه القطيعة مع الشعب في أغلب مراحل وفترات تاريخها الوجودي.
2 - طغيان وتسلط النظام الجديد (نظام هادي- باسندوة- المشترك) الذي أعقب حقبة صالح والذي وصل أصلا على أعتاب الثورة الشبابية الناشبة في فبراير 2011.
3 - فشل مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الخروج بحلول جذرية وفاعلة لأغلب مشكلات البلاد الشائكة والمعقدة.
4 - استمرار حالة الانقسام وتعدد الولاءات داخل المؤسستين العسكرية والأمنية ما بين نظام صالح المطاح به ونظام هادي الذي أعقبه، ودخول البلاد حالة من الاستقطاب والاستقطاب المضاد.
5 - استمرار سطوة وهيمنة النظام السياسي التقليدي العتيق والدولة العميقة المكونة من تحالف اليمين الديني والعشائري بإنتاج نفسه بوسائل وشعارات جديدة ومبطنة محكما سيطرته وسطوته التقليدية على حياة ومقدرات الشعب والبلد... الخ.
وهي أسباب وعوامل لعبت في مجملها دورا محوريا ومؤثرا ليس فحسب في تجريد النظام الوليد (نظام هادي- المشترك) من شرعيته الوطنية، وإنما أيضا في إبطال مفعول الدعاية التحريضية على الصعيدين الديني والسياسي التي شنت ضد "الحوثيين" في اليمن بوصفهم أساس الفوضى والتخلف والاستبداد الذي ميز حقبة نظامهم الملكي القديم الذي هيمن على شمال اليمن خلال أغلب عقود القرن العشرين قبل أن يطاح به في سبتمبر 1962.
ولذلك شكل استيلاء "الحوثيين" على السلطة في سبتمبر 2014 من وجهة نظر الكثير من القوى الجماهيرية والشعبية خطوة مهمة في اتجاه تصحيح الأوضاع كافة على الصعيد الوطني وتخليص البلاد من عبث وهيمنة القوى السياسية التقليدية والفتنة.
إن أبرز أسباب وعوامل نشوب الحرب الراهنة والتدخل الإقليمي بقيادة السعودية هي ذاتها الأسباب والعوامل الكامنة وراء نشوب جولات الحروب الست السابقة خلال الفترة من يونيو 2004 إلى 2014، ما بين نظام صالح ومن بعده هادي وبين "الحوثيين"، مبعثه الأساس الخلاف الديني التاريخي المتجذر بين أتباع المذهب السني المتبع في السعودية وفي أغلب مناطق اليمن الأوسط والأسفل وبين أتباع المذهب الشيعي الذي يتبعه "الحوثيون" المتمركزون تاريخيا في المناطق الأعلى (محافظة صعدة) تحديدا المتاخمة للحدود الجنوبية للسعودية... الخ.
بيد أن هذا الانقسام المذهبي- الطائفي وجد طريقه للتوظيف والتوسع عبر القوى الإقليمية: السعودية السنية، وإيران الشيعية، اللتين تتنافسان على الزعامة الإسلامية في المنطقة العربية والإسلامية.
ولهذا السبب ظلت السعودية وفي أغلب جولات الصراع المسلح السابقة بين السلطة و"الحوثيين" حاضرة ومشاركة ومتدخلة بقوة لتحديد وجهة ونتائج الصراع المتكرر ضد مصلحة "الحوثيين" الذين ترى في تنامي قوتهم ونفوذهم على حدودها الجنوبية خطرا يهدد أمنها القومي وعاملا لتقوية النفوذ الإيراني المتمدد في المنطقة.
ولهذا فإن مبادرة السعودية بتشكيل ذلك الحلف العسكري والتدخل في اليمن بتلك القوة التي اتسمت في العديد من نواحيها بالهمجية لا يشكل انعكاسا فحسب لمخاوفها من تنامي النفوذ الشيعي المنافس لزعامتها في المنطقة، بقدر ما يعكس في الوقت ذاته رغبة المملكة في السعي مبكرا لتجنب وقوع اليمن في قبضة النفوذ الإيراني الموسع في المنطقة كما هو الحال بالنسبة للعراق الذي خرج من دائرة النفوذ السني بعد الإطاحة بالبعثيين وكذلك لبنان (حزب الله)... الخ.
في الأخير كان الإخفاق هو المحصلة الرئيسية لمجمل أطراف الحرب والأزمة اليمنية، فيما الخاسر الأكبر هو الشعب اليمني وبلادنا التي باتت أنقاضاً بفعل الدمار الممنهج الذي طالها ولا يزال حتى اللحظة.
* الرئيس التنفيذي لحركة الدفاع عن الأحرار السود في اليمن ـ رئيس قطاع الحقوق والحريات في الاتحاد الوطني للفئات المهمشة في اليمن.

.jpg)











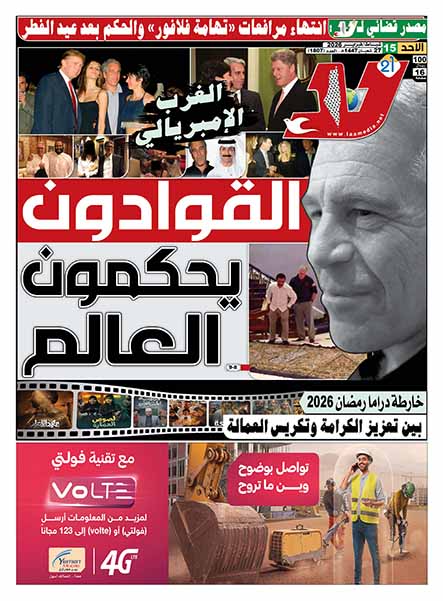
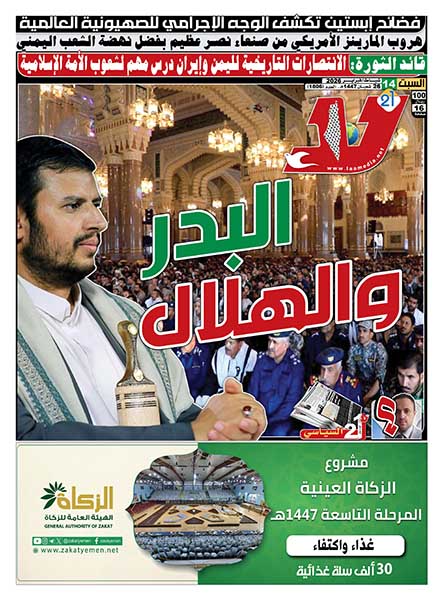


المصدر محمد القيرعي
زيارة جميع مقالات: محمد القيرعي