
مقالات ابراهيم الحكيم
كير الفوضى!
خديعة فبراير!
صناعة الكرب!
كلنا يمنيون
عصابة الأمم!
حفيد الاحتلال
غيــــــــرة زائفـــــــة!!
يــوم الكــلام!
بوق القنابل!
شعيرية بالدم!
الذئاب.. والانتخاب
بونجور مدام!
طراطير العصر!
أجردت!
خُمس أممي!
أُهْكُومــــة!
قميص «مكة»!
صراف الأزهــر!
استحمارات!
فاسد محرج!
باتر فوت!
النهاية (THE END)
عدوان جاري!!
سلاح حقير!
لمن الجنوب؟
الحنــــــــــــوب!!
دولة الحلابين!
اصطخاب!
مسمار إنجليزي!
عقد نقص!
1994 عكساً!
ألغام صنعاء!!
مظلومية الجنوب!
سعر اليمني!
سقف المصالحة؟!
القبح واحد
مَن تكون؟!
يكفي هواناً!
نصر حق
دماركوا
«أكتوبر» مرتـقب
برملة!
مفخخات ثلاث!
عزاء سوداني!
عذراً محمد
كيانات البشت!
أم المعارك
شيفرة الغاز
اتفاق عنقول لهم!!
ثالوث «شرعوي»!
بشرى الجو
ما عذرهم؟!
تعويض الرواتب
كبسولات نظام
انهيار العظمة!
استثمار الوجع!
فساد بالجملة
حذار الأدعياء!
أول الردع
سقطات!
أفيقـوا
فروق ومروق!
سقطة القرن!
إذن إبادة!
أقذر الحروب!
كفايـة
نهج السقوط!
حرب العصر
جرد أهداف!
إنجازات سوداء
مزاجية الإيمان
مآزق المخرج
عبدربه كوفيد
لطف الله
سننجو
دركتر!
معركة بقاء
تأنسنوا!
انفــــــلات!
تعرٍّ أممي!
ما بعد الردع
بلا عكاكيز!
دهنوهـا!
برنيطـة!
ليسوا نداً
عبرنة!
رهان لاء
أي جمهورية!
يالخيبتهم!
نكبة اليمن!
انتقام مؤجل
ولاية اليمن !
ثورة الهوية
مهر الحرية
لا استثنـاء
مجســـات!
زمركيـة!
داركم!
استحمار!
درس الاحتلال
على بلاطة
لا ينفون!!
لا يحق لكم!!
سادة لا عبيد!
ليتهم أحرار!
ليويون!
شظايا أمريكا
ماذا ينتظرون؟!
مقاولة وقحة!
درب المجد
عاصمة الدم
بـراءة ذمة!
سحت أممي
رأس براس!
بازار الرياض!
لا ارتياض
شلوَبَة!
عنقاء!
عداء سافر
جِبْت نخاسة!
كذب معسبل!
حان الأوان
قالت فلسطين
ملهاة التغابن!
حمى «السيادة»!
نزيف مأرب
تساقط الهلام
طُعم «الشرعية»!
مناورات مُودِع
حصالة تعز!
ارتداد كيد!
رد الأرض!
إشهار غزو
دنبوع كابول!
اقترب الحسم
معيار واحد
يا باطلاه!
شَرَق شَرَق
عَقْرُ الحرية
دولة سفري!
عذرا رسولنا
الرسول يمانٍ
عصابة العُملة
دردحة مستحقة!
إنسانيتهم!
مناحة «التحرير»!
إفاقة العزة
«رامبو» الإماراتي
كذاب أشر!
درس ثمين
المومري ورفاقه!
يا لنفاقهم!
رجال البحرية
إحياء مسخ!
مساومة وقحة!
سعـار الانكسـار!
سنة الله
«إنسانية» مُسيرة!
أرضة الغرب!
هوتولوكوست!
كشفٌ حميد
حلف «شرشبيل»!
صديد الحرب!
اصطفافات غبية!
هراء الرياض!
انكسار الطغيان
طُعم تحلية!
رمق أخير
شَّرْ عِيَّهَ!
مجلس الدمى!
مزاد الأردن!
صناعة العجز!
تخطيط الفشل!
ويمكرون!
قَيْظ الإذلال!
أيقونة العفة
كفاية هدرا!
خدعة!
حرب لاء
دوس الذات!
نشوة القتل!
بين العيون
مفتاح الحرية
خيبة مُرة
نكبتهم!
ما حجتكم؟!
سهوكة!
مآل محتوم
أَنَّى يُؤْفَكُونَ؟!
إنجاز زكي
باطل وقح!
كرامة السجناء
غفلة الهالة!
حفلة الهيمنة!
«ساسة» عاهة!!
تصفيات ثأرية!
غرماؤنا!!
منطق الحسم
صبرهم ينفد!
لهيب الجوع!
يتعرون أكثر!
سلم سلاحك
لبانة أذى!
كفاية استهبال!
لا قلق!
زقرة اليمن!
شنكعة!
كفى سحتا!
كش معاذير!
المطر الإيراني!
سِفْرُ الجبال
أحبوه فقط
باقي دهفة!
أوفـر
مبلوحون!
جرم مركب!
حتى وإن!
اعقلوا!
مزيقات!
لم يتعلموا!
ارحبي يا جنازة
أذن جمل!
افصلوها!
غاغة!
مأزق أكبر!
خبط عشواء!
ملهاتنا!
لو يدرون!
قضاؤنا..!
وقاحة فجة!
فاجعة!
منابحات!
عذرا رسولي!
أخوالا وأنصارا لخاتم الأنبياء والرسل.. اصطفاء اليمنيين
أي كفاءات؟!
طوفان الحق
حرب القرن
صرع الكيان
كربلاء أجد
فُرقان أجَد
أدوات النكبة!
فرقان اليمن
نصر آخر
حنبة أمريكا
ويجرؤون!
سريع الغارات!
صهاينة اليمن!
مِفْرَزة اليمن وغزة
فرزة اليمن
محارم الكيان!
بحرنا أحمر
مأزق الدمى!
رهان اليمن
بعير أمريكي!
ورطة حمراء!
رهاب أمريكا!
احتضار!
خَبَال!!
أفول
طريق طريق!
بعد الهوان!
سلوان غزة
ليلة العدوان
غبنان!!
لو عطس!
الممسرحون!
انخساف!
فاجعة الغرب!
قعرة العراة!
بجاحة الوكلاء
غيظ الكاوبوي!
ارتباط عضوي
آيزنفاير!
نبي الشيطان!
أي تغيير؟!
قيد زلة!
انكشاف آخر
لهب الصرعة!
صميل مُسيَّر!
«تل أنابيب»!
سميع الله هنية
اليوم الموعود
لو كانت مكة!
قراءة في الحكومة الجديدة
برمجة!
سؤال التغيير؟!
ما هو التغيير؟!
مأزقهم أكبر
كفى جدلا!
ليس عبثا
يمن مصطفى
لن ننسى!
فاجعة!
محور المنابحة!
مسرح الطوفان!
احتلال عدن!
استغلال عدن!
النصر الأهم
مقززون!
خاسرون
عرطة
إمامهم!
مَن الشهيد؟
ليسوا صورا!
شهود علينا
ثورة تتقد
ساعة سوريا!
عشرة صفر!
أشرّ المسؤولين!
نكتة الكيان!
غليل العرب
كيان هش
خطر داهم!
مهزلة!
جبال بشرية
إنجاز صفري!
مِعفاقُ
مكاسب غزة
تصنيفة ترامب!
قمار أمريكا!
زفرة أولى!
على المكشوف!
فخ أمريكي!
استرخاص!
قَلْبَة!
قمقم!
مهابة
مناحة!
سقط عمدا!
أدركوه!
قبل الهلكة!
بسم الله
ديدان!
هبة لا رهبة!
خيبة ثلاثية!
رئيس ورطة!
جهاد المسوخ!
فجور سافر!
لمن السيادة؟!
ما دخله؟
حرب يانصيب
طحسة أمريكا!!
عور الكيان!
معركة الحفرة!
جحيم اليمن
دموع قذرة!
بأس يتجدد
بيعة النمرود!
جاثوم اليمن!
غدر بالغدير!
الجرذ الصاعد!
هسترة الكيان!
التغيير بدأ
مأفونون!
تبضيع الذل!
«لعنة غزة»!
حداد الكيان!
باب الدموع!
كماشة غزاوية يمنية!
كيف ينامون؟!
خصماء الله!!
ثقب أسود!
فاجعة الذل!
أمة مبلودة!
نذالة علنية!
ما أوقحهم!
حرق مراحل!!
هيرو-غزة!
بيان العار!
سرحة العـرب!
خيبة ثقيلة!!
أي اختراق؟!
حجر يمنـي
نزع الروح!
حرب جديدة!
درس باهظ!
مهرجون!
طوق أيلول
انحراف!!
صك ذل!!
خيبة الحيلة!
"فلسطين بديلة"!
استحمار!
احتلال مجاني!
عجز العجز!
منحلّون!
اقهروه!
نُذر حرب
عور دولي!
لماذا التورط؟!
إقرار نادر
استعادة خيب!
توقفوا!
حل أوفر!
ملحمة «لا»
سبيل الخلاص
ليته تحررا!
حديث مبرمج!
أوهام الجيل!
عزيزي الجنوبي
فرتكة الجنوب!
ملعـوب!
صمت الذليل!
سقوط حتمي!
انكفاء ذاتي!
بيض وجهه
علم البِيض
تفاضح!
تفصول!!
غسيل أسود!
عربدة!
سارق ومبهرر!!
وا حموداه!
دهدهة!!
نوايا مكشوفة!
زلازل أفتك!

أحدث التعليقات
أبورعد الاعنابي على «محفوظ عجب».. وجوه تتكرر!
عبدالغني الولي على الغذاء والدواء أساسيات تتعرض للإهمال والتدمير
فاروق ردمان على عن الجدل الدائر حول تغيير مقررات التعليم!
انور حسين احمد الخزان على فضول تعزي
الخطاط الحمران بوح اليراع على قضية شرف ثوري لا شرف حجر
جبرشداد على الحسين منا ونحن منه
jbr.sh على كل زمان عاشوراء وكل أرض كربلاء
إبراهيم على هروب «إسرائيل» من الفشل إلى الجحيم
يحيى يحيى محمد الحملي على فجوة خطيرة في ثقافة الشباب العربي
جلال سعيد صدام الجهلاني على تاريخ التدخلات العدوانية السعودية في اليمن وامتداداتها (1 - 4)

إبراهيم الحكيم / لا ميديا -
تسمى القعبة عند الإنجليز «برنيطة» وفي العامية «طاقية»، والأخيرة اقترنت في الحكاية الشعبية بالإخفاء أو التخفي، وهو ما تجسده بريطانيا في الحرب على اليمن، يظهر دورها فيها ولا يظهر.. يظهر في رسم سيناريو الفيلم وإخراجه، ولا تظهر في تأدية أدواره الخطرة أو الحرجة، التي تحيلها إلى كومبارس يؤديها، لكنها تظل بطلة الفيلم في النهاية.. تابعوا معي.
بريطانيا أيدت التدخل العسكري للسعودية وتحالف حربها على اليمن، وسوغته بتمرير القرار 2216، وأعلنت دعمها اللوجستي للتحالف، وقال سفيرها حينها إن التدخل جرت دراسته مع بريطانيا منذ أشهر، وأكدت صحف بريطانية مشاركة بريطانيا في تدريب الطيارين السعوديين، بل أكدت مشاركة قوات بريطانية في عمليات عسكرية مساندة للتحالف.
مع ذلك، ورغم حضور رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تريزا ماي، قمة لدول الخليج وتأكيدها «وقوف بريطانيا الكامل مع التحالف ودعم أهدافه»؛ تفضل بريطانيا أن تظهر وسيطا دوليا لـ»دعم إنهاء الصراع في اليمن وإزالة أسبابه وتداعياته على الأمن الإقليمي والدولي» وإحلال السلام، حتى وهي تبرم صفقات أسلحة مع دول التحالف بقيمة 4,5 مليار جنيه استرليني أكثر من هذا، أن الحكومة البريطانية رأت إلغاء تعاهدها «بضمان ألا تستخدم أسلحتها ضد المدنيين» الذي كانت التزمت به لمحكمة تنظر في دعوى حقوقية بمشاركة بريطانيا في انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن، وأعلنت وزيرة التجارة البريطانية أخيرا استئناف صادرات الأسلحة والذخائر للسعودية، بدعوى أن «استخدام الأسلحة لا يعني بريطانيا»!
لا ينتهي هنا، الدور البريطاني غير الجاد في التخفي الكامل، هناك أيضاً «بحث وزير الدفاع البريطاني مع نائب وزير الدفاع السعودي تعزيز وتطوير التعاون العسكري في الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي والبحر الأحمر» غداة إعلان وزارة التجارة البريطانية استئناف صادرات الأسلحة والذخائر البريطانية للسعودية، وإلغاء تعاهد بألا تستخدم ضد المدنيين.
وحيال تجدد استخدام الطيارين السعوديين الذين دربتهم الأكاديمية الملكية العسكرية البريطانية، أسلحة بريطانيا في قصف المدنيين، يبرز دور آخر تمارسه لندن، لا يتجاوز «التعبير عن القلق» في أحسن الأحوال، مع إضفاء تبادل «الإدانة والاستهانة» بين سفير بريطانيا في اليمن مايكل آرون، ومواطنه البريطاني، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيتث.
حدث هذا مجدداً، مع مجزرة قتل طيران التحالف السعودي الإماراتي 7 أطفال وامرأتين وجرح 3 أطفال آخرين، بقصف منزل نايف مجلي في مديرية وشحة بمحافظة حجة، وبعدها بـ3 أيام فقط مجزرة قتل طيران التحالف 25 امرأة وطفلا وجرح 7 نساء وأطفال، بقصفه حفل ختان في منطقة المساعفة الخاضعة للتحالف بمديرية الحزم بمحافظة الجوف.
تابع جميعنا إعلان غريفيتث «استهجان قصف المدنيين في الجوف»، وأنه «يجب أن يتم التحقيق في الواقعة بشفافية»، وتابع جمعنا أيضاً إعلان السفير البريطاني مايكل آرون قلقه البالغ حيال «استمرار سقوط المدنيين»، وليس استهداف طيران التحالف لهم، وإعفاءه الأخير من «التحقيق الدولي» الذي طالب به غريفيتث عبر «ترحيبه بقرار التحالف التحقيق في الحادثة»!
يأتي هذا بالتزامن مع تحركات كثيفة لبريطانيا حيال أزمة ناقلة صافر (الخزان النفطي العائم) في ميناء رأس عيسى، وإطلاق تحذيرات صاخبة من مخاطر التسرب المحتمل لنفطها جراء تهالكها وتوقف صيانتها، و»تداعياته الكارثية على حياة الأسماك والأحياء البحرية وفرص عمل الصيادين ونشاط ميناء الحديدة»، والسعي لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي بشأنها!
لا أحد ينكر المخاطر البيئية والاقتصادية لأي تسرب أو اشتعال محتمل للناقلة، وسبق لصنعاء التحذير مرارا وتكرارا منذ منع التحالف وصول سفينة وقود المازوت لتشغيل محركات تبريد الناقلة، ولا تعارض حكومة الإنقاذ إرسال فريق فني أممي لصيانة الناقلة، بل طالبت بذلك مرارا، كما طالبت بتصدير نفطها وتوزيع عائداته على مركزي صنعاء وعدن لمرتبات الموظفين.
مع ذلك، تقوم قائمة بريطانيا حيال «الخطر الذي يهدد حياة الأسماك والأحياء البحرية»، ولا تفعل بالمثل أو حتى بربع القدر من التحرك والاهتمام والتحذير مع خطر قتل طيران التحالف المدنيين وجرحه عشرات الآلاف، ولا مع حصاره ميناء الحديدة وتقييد تدفق سفن الغذاء والدواء والوقود، بما يعنيه ذلك من إعدام المقومات الأساسية اللازمة لحياة نحو 20 مليون إنسان!
كذلك حيال الصراع في جنوب اليمن، والانفلات الأمني والخدمي، يقول السفير آرون في لقاء مع صحيفة «الشرق الأوسط «السعودية، إن بلاده تتفهم مطالب «الانتقالي الجنوبي» بالانفصال، لكنها ترى أن الوضع في اليمن لا يحتمل مزيدا من الصراع، خصوصاً مع جائحة كورونا، ولا تنصح باتخاذ قرارات وخطوات أحادية». بمعنى نؤيد الانفصال إنما ليس الآن!
تلك لمحة سريعة، لأبرز - وليس كل - تحركات بريطانيا جدة دول تحالف الحرب على اليمن، وكيف أن دورها يظهر ولا يظهر.. يتخفى دون إتقان، ويتعرى دون قفطان، حدا يدركه العميان، ولا يخفى على الشارد والسرحان، وعلى نحو يظهر بريطانيا، تؤدي دور الكابتن أو القبطان، وقبل هذا العراب والمعمدان، لحرب تحالف العدوان على اليمن.. الكيان والمكان والإنسان!

.jpg)






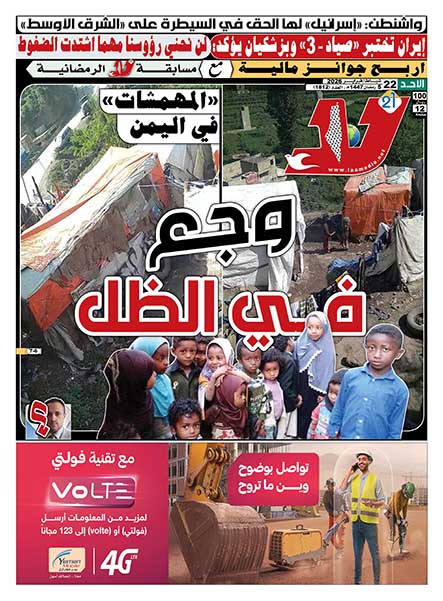





المصدر ابراهيم الحكيم
زيارة جميع مقالات: ابراهيم الحكيم