«الزمن الجميل».. هـــل كـــان جميــــلاً حقـــاً؟! الحلقة 92
- مروان ناصح الثلاثاء , 3 فـبـرايـر , 2026 الساعة 12:08:01 AM
- 0 تعليقات

مروان ناصح / لا ميديا -
الكاتب الرسمي.. حين تصبح الكلمة وظيفة
في ذلك "الزمن الجميل"، كانت الكلمة تلبس بزّتها الرسمية قبل أن تخرج من فم صاحبها، وكانت الأقلام تُفتَّش على أبواب الدواوين قبل أن يُسمح لها بالكتابة.
لم تكن الثقافة تُقطف من بساتين الروح، بل تُجنى من حدائق حكوميةٍ مسوّرةٍ بالشعارات.
هناك، بين المكاتب الرمادية والملفّات الممهورة بختم "الموافقة"، كانت تُصنع صورة المثقف كما تُصنع صورة الزعيم: مهيبة من بعيد، خاوية من الداخل.
الفقراء.. ورثة الحلم المحروم
كان الغرباء عن الرفاه هم أكثر من حملوا بذرة الموهبة.
أبناء الأرياف الذين عرفوا الجوع كما اختبروا الشمس الحارقة، والطلبة الذين كتبوا على دفاتر الديون، والشعراء الذين باعوا معاطفهم ليشتروا ورقاً.
هؤلاء دخلوا المدينة وفي صدورهم لهب الحلم؛ لكنهم اصطدموا بواقعٍ لا يقرأ الشعر إلا إن بدأ بالتحية وانتهى بالولاء.
حين تتحول الموهبة إلى طلب وظيفة
لم يكن الكاتب الرسمي بالضرورة انتهازيّاً، بل كان -غالباً- شاباً حاول أن يعيش على ضوء قلمه فخذله الضوء.
ذهب إلى أروقة الدولة المحتكرة لوسائل النشر، فاستقبلوه بابتسامةٍ معلّبة، وقالوا له: "نقدّر موهبتك.. نمنحك فرصة".
وكانت "الفرصة" عقداً صامتاً: أن تكتب كما يُراد، لا كما ترى.
أن تستبدل الجوع بالسكوت، وأن تُؤجّر قلمك على أمل الترقية الأدبية.
الكرسي لا يعضّ.. لكنه يخنق الحنجرة
تُمنح له بطاقة، ويُستدعى إلى المهرجانات، تُنشر صوره في الصحف، ويُقال له: "أنت مثقف الوطن".
لكن الوطن الذي يقف وراء المايكروفون لم يكن هو الوطن الذي يسكن القصيدة.
شيئاً فشيئاً، يكتشف الكاتب أن الكرسي الذي جلس عليه ليس مقعد تكريم، بل قيدٌ مدهون بالمديح، وأن المايكروفون لا يُضخّم صوته، بل يُعيد صدى التعليمات.
النص الواحد.. بخمس نبراتٍ مختلفة
في مكاتب التحرير كانت الجُمَل يُعاد تدويرها كما تُعاد صناعة الورق:
"في ظل القيادة الحكيمة..."، "تحت راية النهج الاشتراكي..."، "الثقافة درع الهوية وطريق التحرير..."...
وكان الكاتب يكتبها مرةً شعراً، ومرةً نثراً، ومرةً مقالة، ومرةً تقريراً، ومرةً شعاراً، حتى صار النصُّ الواحد يرتدي خمسة أقنعةٍ مختلفة ليقول المعنى ذاته: لا جديد تحت الرقابة.
الموهبة حين تختنق أو تُباع
بعضهم ترك السرب وهاجر إلى صمته وجوعه، كتب في دفاتره دون شهودٍ ولا طابعات. وآخرون غادروا إلى المنافي بحثاً عن هواءٍ لا يُستأذن في تنفسه.
أما من بقوا فقد تعلموا الحيلة: أن يجعلوا القصة رمزيةً كي تمرّ، والقصيدة مديحاً كي تُطبع، والمسرحية نشرة أخبارٍ منمّقة.
كانت الموهبة هناك كطائرٍ في قفصٍ ذهبي: قد يغنّي، نعم؛ لكنه لا يطير.
المنفى.. حين يتبدّل القيد ولا يسقط
أما أولئك الذين استطاعوا الهجرة، وكانوا يملكون ما يكفي ثمن التذكرة أو الحظ، فقد وجدوا في الخارج قيداً آخر بلونٍ جديد.
في صحف العرب في أوروبا، وفي الإذاعات التي ترفع شعار الحرية، واجهوا أنظمةً من الطراز ذاته: تغيّر العلَم؛ لكن بقيت الرقابة.
من هرب كيلا يبيع نفسه في الداخل، باعها في الخارج بأرخص الأثمان؛ إذ اكتشف أن الحرية الإعلامية المزعومة ليست سوى صدى لسياسات أخرى، وأن الكلمة لا تزال موظفة؛ لكن هذه المرة في مكتبٍ أنيقٍ يطلّ على برد المنفى.
المثقف بين الخوف والجوع
لم يكن الخضوع دوماً ضعفاً، بل أحياناً غريزة بقاء.
كان الكاتب يحسب كلماته كما يحسب العامل خبزه اليومي.
يكتب ما لا يحرجه غداً، ويحذف ما قد يُخصم من مكافأته.
كان يخاف أن يجوع، فيجوّع قلَمه أولاً.
الكلمة التي أُطفئ سراجها
في ذلك الزمن الجميل، صارت الكلمة تُقال لا لتُحرّر، بل لتُهدّئ، لا لتُشعل نوراً، بل لتُرضي.
كانت القصيدة تُوزن على ميزان السياسة، والمقال يُقاس بدرجة الانضباط، حتى فقدت اللغة حريّتها، وصارت الكلمات تتجوّل في النصوص كجنودٍ في استعراضٍ رسمي.
خاتمة:
لم يكن الكاتب الرسمي خائناً؛ لكنه كثيراً ما كان أسيراً لزمنٍ أراد من الثقافة أن تكون مرآة لا نافذة.
ذلك الزمن، الذي يُسمّيه الناس اليوم "جميلاً"، كان في أعماقه قاسياً على الجمال ذاته، تعلّمنا فيه الخوفَ كما يتعلّم الخطّاطُ دقّة اليد.
صار الحذرُ جزءاً من الأسلوب، والصمتُ جزءاً من البلاغة.
وربما، لم يكن الزمن الجميل جميلاً إلا لأننا لم نكن -تحت ثنائية الخبز والخوف- نرى قيوده يومها.
لقد كان زمناً غابت فيه الحدائق، وبقيت الأسوار.
رحلت فيه النار، وبقي الرماد.

.jpg)








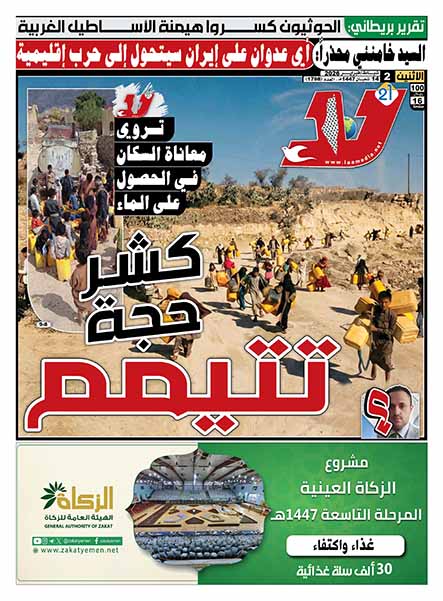






المصدر مروان ناصح
زيارة جميع مقالات: مروان ناصح