«لم يقم الفلاسفة إلا بتفسير العالم، لكن الهدف هو تغييره»...نظرة في كتاب «القمصان السوداء والحمر» لمايكل بارينتي
- نذير محمد الثلاثاء , 3 فـبـرايـر , 2026 الساعة 12:08:10 AM
- 0 تعليقات

نذير محمد / لا ميديا -
رحل يوم 24 جانفي المفكّر الماركسي والباحث في العلوم السياسية مايكل بارينتي، أحد أبرز منظّري النقد لبُنى السلطة، والإمبريالية، والفاشية، ودور الإعلام في إنتاج الوعي وتطبيع الهيمنة، والذي وافته المنية عن عمر ناهز الثالثة والتسعين.
من هو مايكل بارينتي؟
مايكل بارينتي هو مفكر ومناضل وأستاذ محاضر ماركسي أمريكي، ينحدر من أسرة عمالية إيطالية مهاجرة إلى الولايات المتحدة. يُعرَّف في الأدبيات العامة بوصفه عالم سياسة ومؤرخًا أكاديميًا وناقدًا ثقافيًا، وقد شغل مناصب تدريسية في عدد من الجامعات داخل الولايات المتحدة وخارجها، وخاض تجارب في العمل السياسي المباشر، وخلّف إرثًا فكريًا واسعًا تمثل في ثلاثة وعشرين كتابًا وعشرات المقالات، تُرجمت أعماله إلى ما يقارب ثماني عشرة لغة.
غير أنّ اختزال بارينتي في صفته الأكاديمية لا يفي بتجربته الفكرية حقها. فقد مثّل حالة نادرة داخل الوسط الأكاديمي الأمريكي، الذي سعى طويلًا إلى احتواء الماركسية وتحويلها إلى خطاب نظري منزوع جوهره الطبقي. تعامل بارينتي مع الماركسية بوصفها ممارسة نقدية منحازة للصراع الاجتماعي، لا كنظرية تفسيرية محايدة، ورفض الفصل المصطنع بين إنتاج المعرفة والانخراط السياسي. بالنسبة إليه، لم تكن الأفكار كيانات بريئة، بل أدوات تتحدد قيمتها بموضعها من علاقات القوة: إما أن تكرّس الهيمنة أو تساهم في تفكيكها. ومن هنا، ظل حضوره إشكاليًا ومقلقًا للمؤسسة الأكاديمية والإعلامية السائدة، وتعرّض للتهميش المنهجي رغم الانتشار الواسع لأعماله خارج الأطر النخبوية.
أحد أهم إسهامات بارينتي يتمثّل في تحليله لما يُعرف بـ«الثورات الملوّنة»، وآليات التدخل الإمبريالي غير المباشر، ودور الإعلام السائد في إعادة تشكيل الوعي الجمعي بما يخدم مصالح رأس المال العالمي. على سبيل الذكر، كان مايكل بارينتي من بين القلة ممن دعموا الجماهيرية الليبية في وجه هجمات حلف الناتو سنة 2011، وحتى بعد سقوط النظام لم يشارك في الاحتفاء الذي شهدته بعض الأوساط اليسارية في الغرب، بل وحتى في العالم العربي. على العكس، نشر على حسابه في فيسبوك تحليلاً حول ما ستخسره ليبيا نتيجة سقوط الدولة.
في كتابه Democracy for the Few، قدّم بارينتي تفكيكًا جذريًا للسردية الليبرالية حول الديمقراطية الغربية، مبيّنًا أن ما يُقدَّم باعتباره حكمًا للشعب لا يتجاوز، في جوهره، كونه إدارة سياسية لمصالح الأقلية المالكة. فالدولة الحديثة، في تحليله، ليست كيانًا محايدًا فوق الطبقات، بل بنية منحازة بنيويًا لرأس المال، بينما تُختزل المشاركة الشعبية في آليات انتخابية شكلية لا تمس مراكز القرار الاقتصادي. وهكذا، لا تُلغى الديمقراطية صراحة، بل تُفرَّغ من مضمونها الاجتماعي، لتتحول إلى إطار إجرائي بلا سيادة شعبية فعلية.
أما في Inventing Reality، فقد قدّم بارينتي تحليلًا نقديًا معمّقًا لدور الإعلام في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة، موضحًا أن السيطرة الإعلامية لا تقوم أساسًا على التضليل المباشر، بل على الانتقاء المنهجي للمعلومات، وضبط أفق النقاش العام، وتحديد ما يُسمح له بالظهور وما يُحكم عليه بالإقصاء والصمت. الإعلام، وفق هذا المنظور، ليس ناقلًا محايدًا للواقع، بل جهازًا أيديولوجيًا يساهم في إعادة إنتاج الهيمنة الطبقية عبر تنظيم الوعي الاجتماعي، ما يجعله أحد الركائز المركزية لاستقرار النظام الرأسمالي المعاصر.
يُشار هنا إلى أن الكتاب المذكور صدر في الفترة نفسها تقريبًا التي ظهرت فيها أعمال ناعوم تشومسكي وإدوارد هيرمان حول الإعلام، ما يدل على أن بارينتي كان قد بلور مبكرًا فهمًا عميقًا لدور السلطة في إنتاج المعرفة والمعلومة، حتى قبل أن تتكرّس هذه المقاربة أكاديميًا.
بلغ مساهمة مايكل بارينتي النظرية والسياسية ذروتها في كتابه Blackshirts and Reds (القمصان السوداء والحمر، الفاشية العقلانية والإطاحة بالشيوعية)، والذي سيكون محور التحليل في هذا المقال.
صدر كتاب Blackshirts and Reds: Rational Fascism and the Overthrow of Communism سنة1997 في الولايات المتحدة الأمريكية، عن دار النشر اليسارية المستقلة City Lights Books، ومقرّها سان فرانسيسكو، وهي دار معروفة تاريخيًا باحتضانها للأدبيات النقدية والراديكالية المناهضة للرأسمالية والإمبريالية.
ويُشار إلى أنّ هذا الكتاب لا تتوافر له ترجمة عربية حتى اليوم، شأنه شأن معظم مؤلفات مايكل بارينتي التي لم تحظَ بترجمة إلى اللغة العربية. ويُستثنى من ذلك كتابه Democracy for the Few، الذي صدر عربيًا بعنوان «ديمقراطية القلة» عن المركز القومي للترجمة، بترجمة حصة المنيف، ومراجعة منى مطاوعة، وتقديم ممدوح عدوان، وذلك سنة 2005.
خاض المفكر الراحل مواجهة مباشرة مع خطاب الحرب الباردة السائد، ومع تيارات من اليسار الليبرالي التي أعادت، صراحة أو ضمنيًا، إنتاج السردية الإمبريالية عن القرن العشرين. رفض بارينتي المساواة الاختزالية بين الفاشية والتجارب الاشتراكية، معتبرًا أن هذا التماثل يُخفي السؤال الحاسم المتعلق بطبيعة المصالح التي خدمها المسار التاريخي. ومن دون تبرئة التجارب الاشتراكية من أخطائها، شدد على ضرورة تقييمها ضمن سياقها التاريخي والطبقي، وبالاستناد إلى ما أنجزته فعليًا على صعيد التعليم، والصحة، وتقويض هيمنة رأس المال المحلي، لا وفق معايير أخلاقية مجردة صاغها المنتصرون وفرضوها كمرجعية كونية.
فيما يلي عرض تحليلي مبسّط لمضامين فصول الكتاب.
الفصل الأول: الفاشية العقلانية
ينطلق بارينتي في هذا الفصل من تفكيك الصورة الشائعة للفاشية بوصفها انفجارًا جماهيريًا أعمى أو انحرافًا أيديولوجيًا طارئًا، ليقدّمها باعتبارها خيارًا سياسيًا عقلانيًا لجأ إليه رأس المال في لحظات أزمة حادة. فالفاشية، بحسب تحليله، لم تنشأ من فراغ، بل جاءت استجابة مباشرة لتهديد تنظيم الطبقة العاملة لمعدلات الربح وللبنية الرأسمالية نفسها.
يركّز الفصل على العلاقة العضوية بين الفاشية والطبقات المالكة، مبيّنًا كيف لعبت النخب الصناعية والزراعية دورًا حاسمًا في تمويل ودعم الأنظمة الفاشية، سواء في إيطاليا أو ألمانيا. لم يكن صعود موسوليني وهتلر، في هذا السياق، نتاج حماسة شعبية غير منضبطة، بل نتيجة تخطيط ودعم مالي منظم هدفه كسر النقابات، سحق الإضرابات، وتحويل الدولة إلى أداة مباشرة لخدمة المصالح الكبرى.
أما الخطابات العنصرية والقومية المتطرفة، فيراها بارينتي أدوات محسوبة لا تعبيرات عاطفية، استُخدمت لإرباك الوعي الطبقي، وتحويل الغضب الاجتماعي من رأس المال إلى “الآخر” القومي أو العرقي. وبهذا، يؤسس الفصل الفكرة المحورية للكتاب: لا يمكن تقييم أي نظام سياسي خارج أثره الطبقي الفعلي، والفاشية تمثل أقصى أشكال “حل” الصراع الطبقي لصالح رأس المال.
الفصل الثاني: لنمجّد الثورة
ينتقل بارينتي هنا إلى الدفاع عن الثورات الاجتماعية، داعيًا إلى تقييمها من خلال نتائجها الملموسة لا عبر صور العنف المتجزأة. فالثورة، في نظره، ليست فعل تدمير أعمى، بل عملية توسيع للديمقراطية الجوهرية، ووسيلة المحرومين الوحيدة لاستعادة السيطرة على شروط حياتهم.
يقارن الكاتب بين العنف الثوري المعلن، والعنف البنيوي الصامت الذي تمارسه الأنظمة القديمة: المجاعات، وفيات الأطفال، والعمل القسري، والتهميش المزمن. ويرى أن التركيز الانتقائي على عنف الثورات يتجاهل كلفة “الاستقرار” الذي تدافع عنه القوى المهيمنة.
كما يضع بارينتي الدور الأمريكي في سياق الثورة المضادة العالمية، مبرزًا كيف دعمت واشنطن أنظمة قمعية في آسيا وأمريكا اللاتينية تحت شعار “حماية الحرية”، بينما كانت في الواقع تحمي مصالح الشركات العابرة للقارات. وفي مقابل ذلك، يسلّط الضوء على إنجازات اجتماعية حققتها الثورات، مثل التعليم الشامل والرعاية الصحية.
الفصل الثالث: معاداة الشيوعية من اليسار
يفتح بارينتي في هذا الفصل مواجهة نقدية مع قطاعات من اليسار السائد في «الغرب»، التي تبنّت خطابًا عدائيًا للتجارب الاشتراكية من موقع “نقاء أيديولوجي” متعالٍ. ويرى أن هذا الموقف، وإن قُدّم بلباس نقدي، خدم عمليًا السردية الرأسمالية نفسها التي سعت إلى تشويه الاشتراكية.
ينتقد الكاتب فرض معايير مثالية مجردة على أنظمة اشتراكية وُلدت وعاشت تحت حصار اقتصادي وسياسي دائم، ويعتبر أن تجاهل هذا الواقع يُنتج نقدًا غير تاريخي، يميز الراحل بين اشتراكية الدول المحاصرة (تجارب دول الكتلة الشرقية) والاشتراكية النقية.
ويستحضر حالات مثل طرد الشيوعيين من اتحاد العمال الأمريكي أواخر الأربعينيات، ليبيّن كيف أضعف اليسار نفسه حين ساهم في إقصاء أكثر قواه تنظيمًا.
ويخلص الفصل إلى أن هذا النوع من النقد لم يكن بريئًا، بل ساهم في ترسيخ “الكذبة الكبرى” عن الرأسمالية، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن الاعتراف بظروف الحصار لا يلغي الحاجة إلى إصلاحات ديمقراطية داخلية.
الفصل الرابع: الشيوعية في بلاد العجائب
يعالج بارينتي هنا التناقضات الداخلية في اقتصاديات الكتلة الشرقية، مسلطًا الضوء على أثر الجمود الإداري وغياب الرقابة الشعبية الفعلية. يوضح كيف أدّت أنظمة التخطيط الصارمة إلى تشجيع الإنتاج الكمي على حساب الجودة.
كما يشير إلى أن غياب آليات مساءلة حقيقية خلق بيئة خصبة للفساد، حيث لم تكن الحوافز مرتبطة بالأداء الفعلي. ومع مرور الوقت، تراكم استياء اجتماعي ناجم عن الفجوة بين الضمانات الاجتماعية الواسعة ونقص السلع الاستهلاكية.
لا يقدّم بارينتي هذا النقد بوصفه دعوة للتخلي عن الاشتراكية، بل كحجة لصالح إصلاحات ديمقراطية عميقة، محذرًا من أن اللجوء إلى “العلاج بالصدمة” الرأسمالي سيؤدي إلى انهيار اجتماعي واسع، وهو ما أثبتته التطورات اللاحقة.
الفصل الخامس: أصابع ستالين
يتناول هذا الفصل مسألة القمع في الحقبة الستالينية، داعيًا إلى العودة للوثائق الأرشيفية بدل الاعتماد على أرقام دعائية. يستند بارينتي إلى أرشيف جهاز الأمن السوفييتي الذي أُفرج عنه في التسعينيات، ليبيّن أن التقديرات الشائعة حول أعداد الضحايا قد جرى تضخيمها بشكل كبير.
يفرق الكاتب بين أنواع العقوبات، ويشير إلى معدلات الإفراج السنوية عن السجناء، كما يوضح أن أعلى نسب الوفيات تزامنت مع سنوات الحرب العالمية الثانية. ويقارن بين الباحثين الذين اعتمدوا على الأرشيف، وبين كتّاب اعتمدوا التخمين والأرقام غير الموثقة.
لا ينفي بارينتي وجود القمع، لكنه يرى أن تضخيمه أسطوريًا أدى إلى تبييض العنف الرأسمالي المعاصر وصرف الانتباه عن جرائمه الواسعة ووضع التجربة السوفياتية في عهد ستالين وألمانيا النازية في نفس السلة.
الفصلان السادس والسابع: «جنة» السوق الحرة تنتقل شرقًا
يركّز هذان الفصلان على نتائج انهيار الاشتراكية بعد 1991، معتبرًا أن ما حدث لم يكن انتقالًا نحو «الديمقراطية»، بل انحدارًا اجتماعيًا واسعًا. يصف بارينتي كيف ساهمت الخصخصة في عملية نهب منظمة وممنهجة للأصول العامة، وكيف فقد ملايين الناس الضمانات الأساسية التي كانت تكفل لهم الحد الأدنى من العيش الكريم.
يستعرض الكاتب تدهور مؤشرات الصحة والحياة، وانخفاض متوسط العمر المتوقع، ويهاجم خطاب “الإصلاح” الذي بشّر بجنة السوق الحرة. كما ينتقد شخصيات ليبرالية بارزة، معتبرًا أنها ساهمت في إعادة إنتاج هيمنة رأس المال بدل بناء ديمقراطية اجتماعية حقيقية.
ويخلص إلى أن الرابح الأكبر من هذا التحول كان أقلية أوليغارشية، بينما دفعت الغالبية ثمنًا اجتماعيًا باهظًا.
الفصل الثامن: نهاية الماركسية؟
يختتم بارينتي كتابه برفض أطروحات “نهاية الماركسية”، مؤكدًا أن التحولات المعاصرة تجعل التحليل الطبقي أكثر إلحاحًا لا أقل. ينتقد تفكيك الواقع الاجتماعي إلى فئات معزولة، ويرى أن خطاب “الطبقة الوسطى” يُستخدم لإخفاء آليات الاستغلال.
بالنسبة إليه، ليست الماركسية أيديولوجيا منتهية الصلاحية، بل أداة تحليلية لا غنى عنها لفهم تركّز الثروة، ودور الدولة، واستمرار الصراع الطبقي. وتتمثل خلاصة الكتاب في الدعوة إلى كسر الوهم الليبرالي حول السوق الحرة، وإعادة قراءة التاريخ والحاضر من زاوية من يملك السلطة ومن يدفع الثمن.
الخاتمة الجزئية
يقدّم التحليل المتماسك الذي يطرحه كتاب «القمصان السوداء والحُمر» تذكيرًا حادًا بأن تفكيك هيمنة الطبقات المالكة ومواجهة السرديات المعادية للشيوعية لا يندرجان في إطار الجدل النظري المجرد، بل يشكّلان شرطًا أساسيًا لبقاء الإنسانية نفسها في عالم يقوم على منطق التراكم اللامحدود للأرباح.
وفي سياق الأزمات البيئية والاجتماعية المتفاقمة، يصبح الوعي بهذه الحقائق ضرورة ملحّة؛ فحتى وإن لم تفضِ الحقيقة فورًا إلى التحرر، فإنها تظل المدخل الأول الذي لا غنى عنه لبناء أفق إنساني متحرر من أشكال القمع المهيمنة.
الخاتمة
في سياقنا العربي، تكتسب أعمال بارينتي أهمية خاصة، لأنها تتيح أدوات تحليلية لفهم التبعية، وإعادة إنتاج الهيمنة، وتشويه الوعي السياسي، دون السقوط في اختزالات ثقافوية أو خطاب أخلاقي مجرد. ومن هنا، فإن محدودية انتشاره عربياً لا تعكس وزن إسهامه النظري، بل تكشف عن فجوة حقيقية في تداول الأدبيات الماركسية النقدية غير المُدجّنة.
يقدّم لنا مايكل بارينتي درسًا بالغ الأهمية مفاده أنّ المثقف المشتبك يمكن أن يوجد حتى في قلب المركز الإمبريالي نفسه، وأنّ الاشتباك لا يُختزل بالضرورة في صورته التحررية المسلّحة، كما تجسّد في تجربة الشهيد الفلسطيني باسل الأعرج، بل يتخذ أيضًا شكل الانخراط اليومي في قضايا الناس ومصالحهم المادية والدفاع عنها في الفضاء العام. فالمثقف المشتبك، بهذا المعنى، هو من يضع معرفته في خدمة الصراع الاجتماعي، لا من يكتفي بمراقبته أو التعليق عليه من مسافة آمنة.
ويميز هذا الموقع بارينتي عن عدد من رموز النقد الغربي، مثل تشومسكي ومفكري مدرسة فرانكفورت، الذين انشغلوا غالبًا بتفكيك الخطاب والسلطة على مستوى أخلاقي أو ثقافي، دون ربط عضوي ومستمر بالبنية الطبقية وبحاجات الفئات الشعبية المباشرة. فقد اختار بارينتي أن يخاطب جمهورًا واسعًا، وأن يكتب بلغة مفهومة ومباشرة، وأن يواجه السرديات الإمبريالية لا بوصفها انحرافات معرفية فحسب، بل باعتبارها أدوات مادية لإدامة الاستغلال.
في زمن تتكثف فيه الأزمات البنيوية للنظام الرأسمالي، وتتصاعد فيه الحروب، وتُعاد فيه هندسة الوعي، تبدو الحاجة إلى أدوات تحليل من طراز ما قدّمه بارينتي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
ومع رحيله، فإن إسهاماته ستظل حاضرة بوصفها جزءًا من ترسانة النقد الماركسي الضرورية لفهم العالم وتغييره...

.jpg)








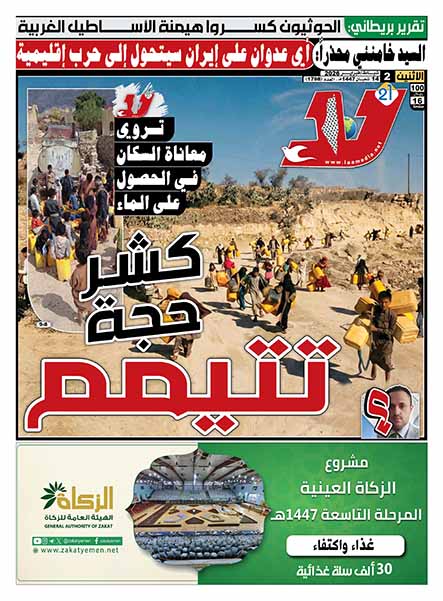






المصدر نذير محمد
زيارة جميع مقالات: نذير محمد