«الحديدة» مؤثثة بإباء المجاهدين وعامرة بصمود اليمنيين
- مرتضى الحسني الجمعة , 4 نـوفـمـبـر , 2022 الساعة 7:02:28 PM
- 0 تعليقات

مرتضى الحسني / لا ميديا -
في ليلة ليست ببعيدة والسماء ملتفة بعباءتها المطرزة بالنجوم وعلى صدرها يستلقي هلالٌ تدنى من عنقها، مُشكّلِةً بذلك لوحة إلهية تُثْمِلُ الطرف كلما امتدّ إليها؛ في ذاك المساء اختارتني الصدفة للبدء في رحلة بميعاد حفل زفاف منتظر لأحد الأصدقاء في منطقة عبس بحجة فأخذت أطوي الطريق على جناح فضول المعرفة ودهشة الزيارة الأولى، سفر يطول بالصمت ويقصر بالحديث وما إن انقضى العرس حتى غادرنا عبس -وبدون ميعادٍ- إلى مدينة الحديدة في رحلة كنت فيها أكثـر الحاضرين شغفاً وفرحاً، فهذه المرة الأولى التي سأزور فيها الحديدة وأول مرة سأرى فيها البحر وألمسه وأحس بدفء مائه وجمال لونه وعَدْوِ أمواجه وانسياب أشعة الشمس الذهبية من سطحه حتى أعماقه،
أراهُ عيناً بعينٍ فأعرفُهُ ويعرفني فقد أحرقتني شاشات التلفاز والهاتف شوقاً إليه فكلما أرميه بالنظر منها يتجاهلني كأنّ لسانه يقول: «هل يغني المرسوم عن كأس الطلا لما يدور؟!» وحرمني منه بُعد المسافات وشحة الإمكانيات وكبّلتني الالتزامات ومن قبلها سنونٌ كنت في معظمها صبياً يدور في فناء قريته المكسوّة خضرةً والمتكئة على ضفاف وادي عنة في العدين، وأكبر رحلاته إلى شاطئ واديها الذي لا يبعد كثيراً -جنوباً- عن الحديدة وبحرها، بل يتبادل معها بعض الأشياء، فمثلاً هو مصبٌّ رئيسيٌ إلى واديها زبيد وأكبر رافديه بمياه السيول، وبالمقابل تجود عليه مع كل العدين ببعضٍ من حرارة مناخها لتجعله مليئاً بالدفء طوال العام لا يحمل برد إب وجبالها ولا سخونة تهامة وصحاراها.
مائةٌ وخمسون كيلومترا أو أكثر كانت المسافة من عبس حتى الحديدة قطعناها في ساعتين مرّت ولم نشعر بها، فأُنسُ الأحباب طغى على وعثاءِ السفر، والتراشق بالضحكات زاد الجو راحةً وأضفى على جمالِ الرحلةِ جمالاً أكثر، وتبادلُ الأشعار وذكريات الطفولة طوى لنا طول الطريق، لاسيما ما كان يأتي به الأخ أحمد الزارقة حتى دخلنا الحديدة من شمالها قُبيلَ الفجرِ وعيني تُفتش عسى أن ترى البحر فلا تراه، ثم تعيد بالنظر إلى السماء لتخبر القمر بأنْ يزيدَ من ضوئهِ لعلّها تجدُ محبوبها فرأتهُ قد أفلِ فلم تيأس واستمرت بالبحث حتى اقتربنا من الميناء، فإذا بانعكاساتٍ تشع من فوق الماء لبعضٍ من ساريات الضوء المرصوصة على حواف الميناء استطاعت أنْ تهدئ الشوق في العيون لساعاتٍ من بقية الليل.
مكثنا قليلاً في المقرِّ الذي وصلناه في أحد الأحياء الممتدة على شارع الميناء، فإذا بالفجر يطل كالحريق فسمعنا مؤذنَ الفجر في الجامع المجاور لنا ينادي بحي على الفلاح فلبيناهُ، وما إنْ قُضيت الصلاة حتى خرجنا فإذا بطائر الصباح يطيرُ من مكمنه والشمس ببطء تفتتح اليوم الجديد الذي لن يعود أبداً حتى تقوم الساعة.. فإذا بي آخذ بيد الأخ زيد المؤيد للذهاب إلى البحر سيراً على الأقدام فيخبرني بطولِ المسافة التي تقارب ثلاثة كيلومترات ولكني لم أستطع فطائر الشوق لم يترك لي مجالاً للتريث ولو قليلاً.. فإذا بالسيارة تأتي فمشينا إلى كورنيش الحديدة؛ فإذا بي ألقى من هيّج صبابتي ومن كاد ينتزع مهجتي، ها أنا أكحل عينيَّ ببهاء لونه، وها أنا أرتمي بين أحضانه وتلعب بي أمواجه وترميني كل موجة للتي بعدها.. كنت أخاله سيستقبلني استقبال الغرباء، ولكنّهُ حفّني بحبٍّ يفوق حفاوة الأم برجوع ولدها الغائب الذي لا يُتوقعُ عودته، سبحت فيه كثيراً كلما أحاول الخروج منه يزيدني إغراءً بدفئه لأعود إليه طمعاً فيه، حتى خارت قواي واستلقيت على شاطئِهِ منهاراً لا أستطيعُ الحركة ولا شيء على لساني سوى ذم البدانة والكرش والكسل الذين أنهكوا جسمي وجعلوني ككتلةٍ من الطين لا تستطيع الحركة، عندها تذكرت أهمية كلام أبي لي بالاهتمام بالرياضة واللياقة البدنية.
على ساحل البحر في الحديدة رأيت شيئاً عجباً.. رأيت هناك اليمن بكلها، اليمن بكل أطيافه، رأيت فيه الصنعاني والعدني والمحويتي والصعدي والإبي والتعزي.. رأيت فيه الزيدي والشافعي والسلفي والصوفي، أبصرت هناك المجاهد والمؤتمري والإصلاحي والاشتراكي، شتات اليمن اجتمع في الحديدة يجمعهم الأمن، يوحدهم البحر، يضحكون جميعاً ويلعبون كرة القدم، أدركت بحقٍّ أنّ الثورة والحرية ودماء الشهداء وحنكة القيادة هي من لمّتهم هنا.
خرجت من البحر مودعاً إياه وعلى وعدِ اللقاء به عصراً، ركبت السيارة مع بعض الزملاء إلى مقر إقامتنا فإذا بي أرى الدمار حولي في كل شارع، لا يكاد يخلو من آثار الرصاص أو القذائف أو الغارات.. آثار جرائم حفرها حقدُ المحتل ودناءة العملاء أرادت نزع الكرامة والعزة من هذه المحافظة التي لم يعرف منها اليمن كل اليمن سوى المدد والحب والراحة.
الحديدة مضرب المثل في البساطة والسكينة والهدوء والطيبة والعنفوان والعلم والطمأنينة، ترى البساطة بين رمالها، والسكينة بين أزقتها والهدوء في بحرها، والطيبة في أوساط أبنائها، والعنفوان في سمرة أهلها، والعلم في تاريخها وجوامعها الضاربة في عمق السنين، والطمأنينة بين أضرحةِ أوليائها.
الحديدة البسيطة في موقعها وأهلها، الحديدة التي تئنُّ بصمتٍ من اضطهاد الإقطاعيين واستبداد الظالمين، أولئك الذين لم يملوا من نهبها واستباحتها وما لبثت حتى تنفست الصعداء منهم بعد ثورة البسطاء والمستضعفين، ثورة الـ21 من أيلول، حتى عادوا وهم أحذية لمحتلٍ لا يرعى فينا إلاً ولا ذمة.
لأكثر من ثلاثة أعوامٍ حوصرت الحديدة وأُمطرت بشتى أصناف الأسلحة؛ سواء التقليدية أو البيولوجية أو الكيماوية، ذاق كل من فيها شتى صنوف الأمراض والعذاب والويلات، خُيّلَ للمعتدين بأنّ هذه وسائلُ ناجعة لتركيعها واحتلالها والسيطرة عليها لكن قوة الله كان لها الأمر فتمثّلت لهم مجاهدين أتوا من كل ربوع اليمن وكانوا دروعاً لها مزجوا دماءهم برمالها وعلى رأسهم الشهيد الرئيس صالح الصماد.. تفوح رائحة دماء الشهداء من كل ثغرٍ من ثغورها؛ من التحيتا إلى الفازة إلى الجبلية إلى كيلو 16 إلى الحسينية إلى الدريهمي التي قيدها الحصار لعامين ولم تستسلم حتى انتصرت على المحتل ومرتزقته، وإلى كل الثغور في جميع مناطق الحديدة.
غادرنا الحديدة نحو صنعاء وعلى الطريق مررنا بديارٍ صارت قفاراً من أثر الحرب في كيلو 7 وكيلو 16.. إلا أنها عامرة بصمود المقاتل اليمني وعنفوانه، مؤثثة بإباء المجاهدين الصادقين، تفوح من بين أسوارها تلك الدماء الطاهرة للذين ارتقوا منها شهداء.. بقيت الحديدة كما هي شامخة وكما أراد الله لها ذلك فاندحر منها العدو خاضعاً ذليلا يعتنق الهزيمة والخسران، فعلى ثراها انتصرت البساطة والمظلومية على الأبهة والظلم، وستبقى الحديدة ذلك البلد الذي لا يغيب بِفُلِّهِ عن كل أفراحنا واحتفالاتنا ومناسباتنا.. غادرت الحديدة ولكنها لن تغادرني وستبقى كل تلك التفاصيل عالقة في ذاكرتي إلى الأبد؛ بحرها ورمالها وحاراتها وأهلها وقفارها وصمودها.. وسيعود طائر الشوق يغني ألمي من جديد حتى أعودها مرةً أخرى.

.jpg)












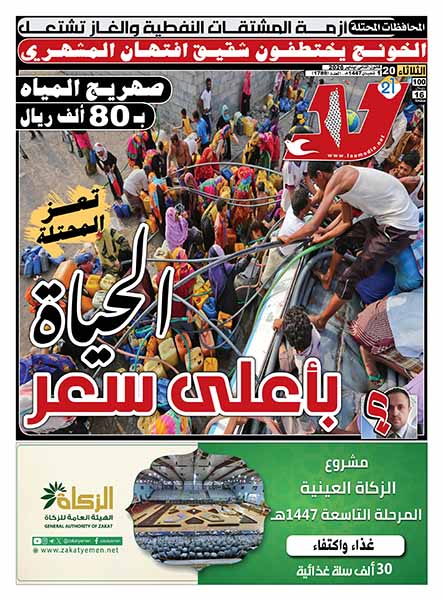


المصدر مرتضى الحسني
زيارة جميع مقالات: مرتضى الحسني