دمشق التي تكظم غيظها
- تم النشر بواسطة خاص / لا ميديا

دمشق - خاص / لا ميديا -
دمشق، تعيش اليوم حالة لا تعيشها إلا في لحظات نادرة من تاريخها، وتحتاج إلى قرن كامل من الزمن على الأقل، حتى تتكرر حالتها هذه، وآخرها كان مع نهاية الحرب العالمية الأولى، يوم سقطت الإمبراطورية العثمانية مع لحظة فقدان سيطرتها على دمشق.
فدمشق ليست مجرد مدينة عادية، أو عابرة للتاريخ.. هي حالة إنسانية، وتاريخ مستمر، وذاكرة حيّة، تروي من القصص والعبر والدروس، أكثر مما ترويه أي مدينة أخرى في العالم.
وهي العاصمة الأقدم في التاريخ، وهي عاصمة بلاد الشام، بما تعني من موقع وتاريخ وموقع جيوسياسي، يعتبر مفتاح منطقة المشرق كله، وبيضة قبان التوازنات الإقليمية والعالمية.
دمشق التي لا يمكن لدولة في المنطقة، أن تحلم بأن تكون قوة إقليمية، بدون أن تكون بجانبها، ولا يمكن لإمبراطورية عالمية، أن تتسيد، بدون أن تضمن وجودها في صفها.
دمشق حيث يوجد المسجد الأموي، أحد أهم وأعظم مساجد العالم، وفيه ما لا يوجد في غيره من المساجد، حيث حط فيه رأسان، من أهم وأقدس الرؤوس البشرية، الأول وهو يوحنا المعمدان (النبي يحيى) الذي عمد السيد المسيح (عليه السلام) بيديه، ومهد الطريق له لأداء رسالته السماوية، ومدفنه موجود في داخل المسجد، والثاني هو رأس الإمام الحسين (رضي الله عنه) الذي استراح لبعض الوقت في المسجد، وهو في طريق الآلام.
دمشق هذه المدينة العجيبة، من يدخلها لا يخرج منها كما دخلها، وخير شاهد على ذلك، شاؤول الطرسوسي، الذي جاء لملاحقة المؤمنين برسالة السيد المسيح (عليه السلام)، فجاءته رؤيا الإيمان، على أبواب دمشق، ودخل إليها مغمياً عليه من الشارع المستقيم الذي لايزال قائماً وخرج منه وقد أصبح القديس بولس، ومن أهم المؤمنين برسالة السيد المسيح، ومن دمشق انطلق مع القديس بطرس، حاملين رسالة الإيمان المسيحي إلى العالم، وفي روما، تم بناء كنيسة الفاتيكان، حيث يوجد مدفن القديس بطرس.
ومن دمشق خرج أبولودور الدمشقي، الأشهر بين مهندسي العالم عبر التاريخ، ليعلّم روما فن البناء والعمارة الدمشقية، ولا تزال العديد من منشآته، التي بناها أيام تلك الإمبراطورية العظيمة، قائمة حتى اليوم.
وإذا وسعنا الدائرة، لتشمل رمزية «دمشق الشام» كعاصمة لبلاد الشام، فنصل إلى حمص، التي خرج منها بابنيان الحمصي، وهو أشهر حقوقيي التاريخ، وهو الذي وضع دستور روما، الذي يعتبر الأساس لكل التشريعات والدساتير الحديثة، حتى الآن.
دمشق هي التي يأتيها الغزاة لتطويعها، فيخرجون منها وقد طوعتهم، بعاداتها وتقاليدها وتراثها وطعامها ولغتها، حتى يصبح من يغادرها، يتحسر على أيامه فيها.
دمشق هي التي صنعت شعرة أخرى، غير شعرة معاوية، وهي التي ترسم حدود العلاقة بين السلطة وتجارها وأهلها، تقول «لكم السياسة ولنا الأسواق» فمن فهم هذه العلاقة، قبلته دمشق، ومن لم يفهمها، سيصعب عليه أن يتعايش معها.
وصناعات دمشق، كانت من العراقة والدقة، أن سادة العالم، وجميلات العصور، كانوا يتفاخرون بأنهم يلبسون من حريرها ونسيجها، الذي اختارت منه ملكة بريطانيا السابقة، فستان عرسها.
ونساء دمشق، لسن نساء باب الحارة، وإنما نساء الأدب والفن والسياسة والريادة والصالونات الأدبية والثقافية، وهن أيضاً نساء الجمال والأنوثة، التي تعرف كيف تجعل منزلها جنة الرجل، وهذه الروح الدمشقية، التي تمثلها نساؤها، لا يمكن أن تراها بهذا الحجم، في أي مكان آخر في العالم، فكانت المقولة، بأن من سعده من يتزوج دمشقية.
ومن أطرف وأبلغ ما حملت الغربة السورية عموماً، والدمشقية خصوصاً، أن هؤلاء المهجرين قسراً، هم يغيرون مجتمعاتهم الجديدة، بدلاً من أن تغيرهم، ويعلمونها عاداتهم وتقاليدهم وأكلاتهم ومشروباتهم، بدل أن يتعلموا عادات بلادهم الجديدة.
قد نتفق أو نختلف، على شخصية معاوية بن أبي سفيان وتوصيفه، لكن الحقيقة تقول، إنه بما عرف عنه من دهاء وحنكة سياسية، أكثر من فهم دمشق، وأهل دمشق، فأشركهم وتشارك معهم الحكم، فكان الحاكم، وكانوا رجال الإدارة، وكوادر الدولة، فكتبه التاريخ، بأنه من أشهر من حكم دمشق.
دمشق هذه، المحملة بكل هذا التاريخ والتراث، والقيم والعادات، تعيش اليوم غربة كبيرة ونادرة، في تاريخها.. في شوارعها، ناس وسيارات ومواكب، من غير ناسها. وحدائقها، لم يعد فيها دمشقيون، ولم يعد السيران جزءاً من عادات أهلها.. وفي ساحاتها، يوجد رقص وغناء ودبكة، لكنه لا يوجد فيه شيء من التراث، والفن الدمشقي.
فقراؤها زادوا، كما لم يكونوا من قبل، وهم اليوم يئنون حد البكاء من غلاء أسعار وفواتير وصلت حد العجز، وحد المس بكراماتهم وكبريائهم.
وتجارها وصناعيوها، و»شيوخ الكار» فيها، إما فاقدون للأمان في بيوتهم وأعمالهم ومكاتبهم وورشاتهم ومصانعهم، أو مهجرون وموزعون في بلاد العالم، حيث أموالهم غريبة، كما أصحابها، فيما بلدهم يحتاج إلى كل أنواع البناء، وهو الأولى بها.
وشيوخها اليوم، هم أكثر من يرفع الصوت، ويشعرون بالألم، وهم يرون أن عقائدهم يتم المس بها، وهم المعروفون بالعقائد والمذاهب الأشعرية والصوفية المعتدلة، التي تقبل الآخر، وتتعايش معه، فيرون أنفسهم وهم خارج منابر مساجدهم، وخارج خطب الجمعة فيها.
ألم دمشق اليوم لا يتحمله طرف واحد، وإنما هو سلسلة ممنهجة من المحطات والسياسات، التي لا تحمل روحها وتاريخها، لكنها اليوم، في ذروة ألمها وغضبها الذي لا يزال صامتاً.
دمشق اليوم صامتة، تكظم غيظها، لكن هذا الصمت ليس عجزاً ولا تخاذلاً ولا تراجعا ولا خوفاً، وإنما صمت الحليم العاقل، وهو صمت أقوى وأمضى من كل الأسلحة، لأنه إذا كان صمت الرضا أعطى الأرض الصلبة القوية لمن يحكم دمشق، أما إذا تم التعبير عن هذا الصمت بالانسحاب، فهذا يعني تفريغ الأرض من تحت أي سلطة مهما كانت.
والسؤال الآن، إلى متى سيستمر صمت دمشق؟! والجواب هو: دمشق هي التي تقرر رأيها، وموقفها، ومتى وكيف، وهي التي تختار، هل ستبقى، أم تنسحب بصمت، وحينها ستكون كلمتها (الصامتة) أقوى من كل الأسلحة.

.jpg)










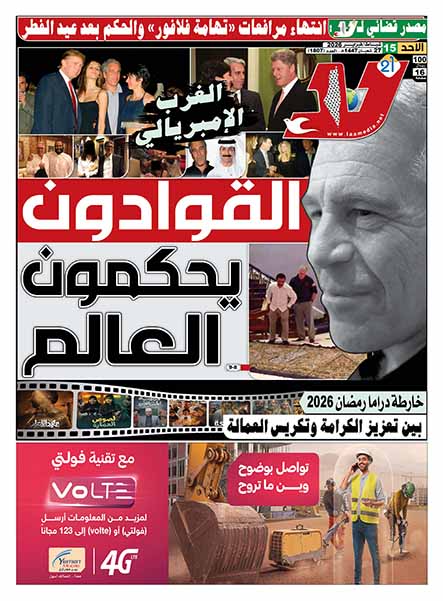
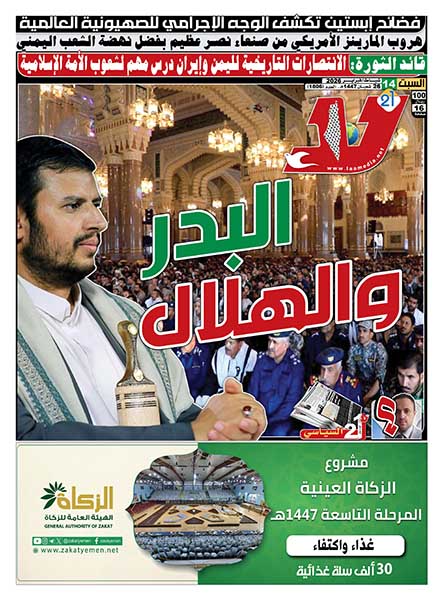




المصدر خاص / لا ميديا