
مارغريـت آتــوود*
ترجمة خاصة: / لا ميديا -
عزيزتي ستيفي:
شكراً لرسالتك. أتمنى أن تكوني على خير ما يرام.
يبدو أننا ملزمون بافتتاح الرسائل بالسؤال عن العافية وكأننا نرفع القبعة وفق التحية الفيكتورية. ألا ترين بأنها أمست واجباً اجتماعياً؟ تماماً كحال بطاقات الزيارة في الماضي؟
«دمتِ سالمة» نختتم الرسالة! يا له من مفهوم سخيف! أيُّ «سلامة دائمة» وكل لحظة تتيح انقطاعَ الخيط الرفيع الذي يُعلقنا قبل أن نهوي إلى غياهب المجهول. علينا أن نحظر مفردة «أمان» لشدة ما تغرسه من أوهامٍ كاذبة بين الناس.
اعذريني إذ بدأتُ أضيق ذرعاً باللغة، لعله شعور المرء بعد تخطيه مرحلة عمرية معينة. فالجيل الناشئ يظن أن الأشياء مازالت تكنى بمسمياتها الحالية، في حين نفطن للفجوات نحن معشر الكبار، ونشعر بالهوة السحيقة بين الماضي والحاضر. نرى دعابات العقود الغابرة فاقدة البريق، فيما تبزغ نكات جديدة قلّما نفهم مغزاها. يبدو أن الفكاهة قد تراجعت في الحقبة المتزمتة التي نعيشها -لا أريد أن أُتّهم بإطلاق الأحكام- فماتزال ثمة فسحة متاحة للضحك.
على مرّ العصور، تتلاشى عبارات كل جيل وتذوي تماماً. من منّا لا يذكر معنى «اثنين وعشرين فرداً سكيدو»؟ نطقتُ العبارة الموروثة منذ طفولتي، لم تكُ تحمل أي معنى سوى أنها جزء من قافية للعبة أطفال. قافية مشؤومة، إن أمعنتُ النظر: مجموعة لصوص اقتحموا منزل سيدة -كانت النساء البالغات يُدعين «سيدات» آنذاك- يصدرون أوامرهم، كأن تدور حول نفسها وتلمس الأرض. لا خير يُرجى لها ولا خلاص: فاللصوص ثلاثة وعشرون والمرأة وحيدة. أما «سكيدو» فكلمة السر التي استخدمتها السيدة للخروج من المأزق، والهرب.
هل أشعر بالوحدة؟ هل أعاني من الألم؟ هل أصبح المنزل خاوياً أكثر مما ينبغي؟ هل أستوفي بحقّ جميع مراحل الحزن؟
كم كنا نمرح بمفهوم الموت! جعلنا من ليلة الهالوين فرصة لوضع ملاءة والتظاهر بأننا أشباح، أو لنملأ وعاءً بالعنب المقشر، نعصّب أعين أصدقائنا الصغار، ونوجه أياديهم نحو الوعاء. «مقلٌ بشرية»، كنا نصدح بأصوات جنائزية.
يا إلهي! يا لها من ردود فعلٍ متوقعة، قهقهة مقززة تعقبها ترانيم الطفولة المعتادة: «ميتون، مدفونون، للديدان طعام، وجثثاً مخضرّة نتحول». في تلك الأيام؛ لطالما بعثتْ سيناريوهات مماثلة على المرح! لكن أين هم الآن، الثلة الكبيرة من الصغار المشاغبين؟ قلة قليلة بقيت. رحلوا، ومعهم تبخرت الصور الطفولية الساذجة، مُقل العنب المتعفنة والجثامين الخضراء المتحللة، كلها ذوت في النسيان.
لم تذر الأيام سوى شيوخ يتشبثون بحافة العمر، يتفيؤون شمس الأصيل يحتسون الشاي ويقضمون الكعك الذي يتناثر فتاتهُ على قمصانهم غير النظيفة. يقضّون مضاجع الجيران بمحاولاتهم المضنية -ببطء وثقل وانزلاق خطر على الجليد- لإزاحة الثلج عن ممرات بيوتهم. «دعني أفعل ذلك عنك يا عم». «لا عليك يا بني، مازلت أقوى على ذلك». خنافسُ بلغت نهاية دورة حياتها، تتسلق بشجاعة ساق الزهرة التي ألفَتها ذات يوم. «أين أنا؟ وما الذي أفعله هنا؟» تتساءل بقلقٍ فيما يتمتم الجيران: «إلى متى سيستمرون؟ بلا ريب ليس لزمنٍ طويل».
لا تظنّي لحظةً أننا غافلون عمّا يختلج في صدورهم. فقد راودتنا الأفكار ذاتها يوماً، بل لا تنفكّ تراودنا.
لكنّ كل هذا ليس من نصيبكِ يا عزيزتي ستيفي. فأنتِ أصغر سناً بكثير مما تظنين. إذا ما أمهلك القدر ثلاثين عاماً إضافية -وهو ما أرجوه لك من صميم قلبي، بل أكثر بظروف جيدة- إن عشت ثلاثين عاماً أخرى وكنت لاتزالين تستمتعين بالحياة، أو بمعظمها على الأقل -إذا ما بقي أحد ليتمتع أو حتى ليعيش في ظل هذا المدّ الهائل المجهول الذي يزحف نحونا- أتوقع أن تنظري إلى إحدى صورك الحالية، هذا إذا ما نجت مقتنياتك الشخصية من الطوفان أو الحريق أو المجاعة أو الوباء أو الثورة أو الغزو أو أيّاً كان البلاء، وستقولين: «يا لزهرة شبابي!».
لكن هذا استطراد طويل. سألتِني عن حالي، مجاملة اجتماعية أخرى. لا أحد يروم إجابة صادقة على هذا السؤال.
ما تعنيه حقاً؛ كيف أتدبر أموري بعد رحيل «تيغ». هل تنهشني الوحدة؟ أيضنيني الألم؟ أغدا البيت أشد وحشة؟ هل أؤدي طقوس الحزن المعتادة كما يتوقع مني؟ أم دخلت النفق المظلم، مرتديةً ثياب الحداد السوداء، بقفازاتٍ وخمار، ثم خرجت من الطرف الآخر، مبتهجةً بألوان زاهية متأهبة لمواجهة الحياة؟
مطلقاً! فما أعبره ليس بنفقٍ ولا نهاية لهذا الطريق. توقف الزمن عن كونه متسلسلاً بأحداث وذكريات مرتبة كخرزات العقد. لعله شعور، لنقل تجربة، أو ربما تشكيلاً غريباً. لست متأكدة من قدرتي على شرحها لك.
نعم! انفرط عقد الزمن الخطيّ، فلم تعد أحداث الحياة خرزاً منتظماً داخل خيط.
سيصيبكِ الفزع لو أخبرتك أن «تيغ» لم يرحل تماماً، وستقفزين فوراً إلى تصوراتي عن الأشباح، أو أوهامٍ عقليّة، أو خرف، لكن لا شيء من هذا يمت للواقع بصلة. ستفهمين لاحقاً، ربما في بعض أجزاء هذا الالتواء أو الانطواء في نسيج الزمن، أن «تيغ» لايزال حاضراً، بنفس القدر الذي كان عليه دائماً.
لا أبتغي مشاركتكِ شيئاً مما أكابده. لا أريدك أن تجوبي الطرقات نحو أحبائي الصغار وأرحامي، تحملين همومي مرتاعة قلقة، وتوحي إليهم بضرورة إنقاذي. لا ألوم محبتك للخير فقلبك يفيض رقة ونواياك حسنة. إلا أنني لا أرغب في تقبلِ أطباق الخير المخبوزة، الاستجوابات المبطنة، زيارات المتخصصين، أو إقناع بنات الأخوات بتخصيص مسكن في دار الرعاية. أبداً! كذلك لستُ تواقة لرحلة بحرية.
هنا، أنعمُ بصحبة ثلةٍ من الأرامل. بعضهن -أو بعضهم بالأحرى- «مُفجوعون» (لم نجد بعد لفظاً محايداً لمن فارقهم رفيق الدرب، ربما يظهر قريباً مصطلح «فاقد الشريك» أو ما شابه، لمّا تتبلور المفردة بعد). فيهن من فقدت رفيقة عمرها، وفيهم من فقد صديقه المقرب، لكن أغلبهن نساء فجعن بفقد أزواجهن. هؤلاء الرجال أشدّ رقة مما ظننا، هذا ما اتضح جلياً.
عمّ نتحدث؟ عن طبيعة الزمن العجيبة، ذلك الانطواء الذي وصفته للتو، والذي خبرناه جميعاً. عن غرائب ونزوات الغائبين. عمّا قالوه -أو مازالوا يقولونه حقاً- في أي مناسبة.
نحن مهووسون قليلاً بمشاهد الموت! نتقاسمها، نعاود خلقها، نعدّلها، نرتبها نعتقها، لعلنا نروم لجعلها أكثر احتمالاً. أيّ رحيلٍ كان الأسوأ؟ هل من الأفضل أن نشهد اضمحلالاً بطيئاً، مع ألمٍ عميقٍ، لكن مع متسع من الوقت للوداع؟ أم أن السكتة الدماغية المفاجئة أفضل أو الفشل القلبي؟
أسهل عليه، أصعب عليك؟
ندرك أن موتهم وشيك. نغادر الغرفة لخمس دقائق ثم يرحلون. طوال عشر سنوات كنا نعرف أن ذلك سيحدث يا له من ترقبٍ فظيع!
تنظيف التركة... أيّ عبء ثقيل! تتراكم الأشياء عاماً بعد عام، حتى إذا ما انفجرت الحياة فجأة، تبعثرت كل المقتنيات التي جُمعت على مر السنين -الرسائل، الكتب، جوازات السفر، الصور، الأشياء العزيزة المحفوظة في الأدراج والصناديق أو على الرفوف- تتناثر هذه الذكريات في أعقاب رحيل النجم أو الشهاب أو موجة الطاقة أو حتى النفس الأخير الصامت. وعلى الأرامل أن يكنسن ويرتبن ويتبرعن ويورثن ويتخلصن من أجزاء روح مبعثرة هنا وهناك. تنخرط الأرامل في هذه المهمة بكل جوارحهن، شؤون تدفعهن في الوقت نفسه إلى حافة الجنون. نتصل ببعضنا البعض، كلنا قلق وحيرة، متسائلات: «ماذا أفعل بـ... (املئي الفراغ)؟» نقدم الكثير من الاقتراحات، ولكن لا شيء يحل المشكلة الأساسية.
لطالما تبادلنا أطراف الندم، أو بعضها على الأقل. ليتني أدركتُ حينها، ليته باحَ بما في صدره، يا ليتني تجرأتُ وسألت. كان عليّ أن أكون أكثر... (املئي الفراغ). لو أننا فعلنا... (املئي الفراغ). كم تركنا من الفراغات الشاغرة.
نحن الأرامل ذوات الحظّ السيئ، هذا ما يظنونه بنا، نحن نعي ذلك تماماً. تخيّم علينا لحظات صمتٍ ثقيلة، والكل يتعامل معنا بحذر شديد. هل ثمة من يريد دعوتنا إلى العشاء؟ أم أنهم يتحاشون جوّ الكآبة؟ بالتأكيد ما لبثنا نحاول آلا نلقي بظلال حزننا على أكتاف أحد.
الأمر فيما مضى كان أدهى وأمرّ، في بقاعٍ أخرى وعصور خلت كنا نُدفن أحياءً مع الملك الراحل، أو نُزجّ معه في محرقة جنائزية. فإذا ما كتبت لنا النجاة من مشاركته الموت، أُكرهنا على ارتداء السواد، أو البياض إلى الأبد. كنا نُحسب جالبات النحس، تحل علينا اللعنات. بل إن عناكب الأرملة السوداء، بسمومها الفتّاكة، سُمّيت تيمناً بنا. لطالما تمتم الناس بالتعاويذ قبل أن يبصقوا اتقاء شرورنا. فإن لم تكن إحدانا قد بلغت أرذل العمر -لايزال في عروقها بعض الدم- نُعتت بالأرملة المرحة، الطليقة، التواقة للتحرر الجنسي الجامح. بهذا لمح رجل مسن لي في إحدى المناسبات.
حين نرتاد الحفلات نطلي أظافر أقدامنا باللون الأحمر القاني، لكننا نرتدي الأحذية لئلا يلمح أحد بريق أصابعنا المتمردة. نعلم أن هذا التزين ضرب من العبث، لكننا لا نتوانى عن ممارسته في متعة صغيرة لا تأخذنا سوى لدربٍ مسدود.
لم يمضِ وقت طويل على لقائي بذاك الرجل، وما إن انتهينا من تبادل المجاملات الرسمية حتى طالعني بشبه ابتسامة ماكرة مستفسراً: «إذن، هل تبحثين عن شريك؟» أطلقها على سبيل المزاح، أو لعله قصد ما قاله، فالأرامل يُنظر إليهن كنساء ثريات، أيضاً أكثر عرضة للإغواء.
وبنبرة حازمة بعض الشيء أجبت: «أنا أرملة تيغ».
«تلقين بشباكك إذن؟».
أظنّه كان ضرباً من مغازلة كبار السن، نوعاً من اللهو الودود يليق بمن بلغ أرذل العمر. مغازلة كهذه، تنطلق دون أن تحمل وعيداً أو إثماً، فالطرفان يعلمان يقيناً أنّها لن تثمر وصالاً، أو لنقل، لا طاقة لها على الإزهار. نحن قاطنون في «حيّ المغازلة العتيق». لو كنت أحمل مروحة يدوية حريرية، لنقرته مداعبةً، كما في مسرحيات النهضة العابثة. «يا لك من مشاغب!».
لن أجرؤ يا عزيزتي على النطق بكلماتٍ مثل «لا تكوني سخيفة، فـ تيغ لايزال هنا». لأن الأقاويل عني ستنتشر كالنار في الهشيم: «فقدت صوابها!». «لطالما كانتْ غريبة الأطوار».
لهذا السبب، نكتم الهواجس في صدورنا، نحن الأرامل.
وغني عن البيان، يا ستيفي، أني لن أرسل لك ما كتبت. فأنتِ على الضفة الأخرى من النهر. حيث تقيمين برفقة حبيبكِ بعكسنا نحن الأرامل.
يجري بيننا نهر لا يمكن عبوره، لذا سألوح لكِ متمنية الخير، وهذا ما سأفعله، وأفعله الآن..
ستيفي العزيزة،
شكراً لرسالتك التي أسعدتني. أرجو أن تظلّ عافيتك في أوجها. لطفٌ منك سؤالك عن حالي، أنا بخير والحمد لله. طال الشتاء على الجميع، لكنه ولّى أخيراً مفسحاً الساحة لإزهار الربيع. أنا منهمكة في أعمال البستنة هذه الأيام، ها هي زهور الثلج تكشف عن بتلاتها، فيما يبعث النرجس براعمه الأولى صوب النور.
يستهويني أن أزرع بعض الزنابق الشرقية في الحديقة الأمامية، فقد اعتدت على زراعتها منذ سنوات، لكن خنافس الزنبق قضت عليها على حين غرة. سأكون على أهبة الاستعداد لتلك الخنافس هذه المرة، فالحذر واجب.
الأبناء بخير، والأحفاد يملؤون البيت بهجةً وحيوية. أُفكر بتبني قطة صغيرة كي تؤنس وحدتي. ليس لديّ الكثير من الأخبار الأخرى. أعلميني متى ستأتين إلى هذه المنطقة، لنتناول الغداء معاً.
دمتِ سالمة، مع خالص التحيات.
نيل.
(*) مارغريت إلينور آتوود: كاتبة وشاعرة وناقدة أدبية وناشطة كندية في المجال النسوي والاجتماعي. إحدى أهم كتاب الرواية والقصص القصيرة في العصر الحديث، حازت على جائزة آرثر سي كلارك في الأدب والعديد من الجوائز والأوسمة الرسمية في كندا وولاية أونتاريو.

.jpg)












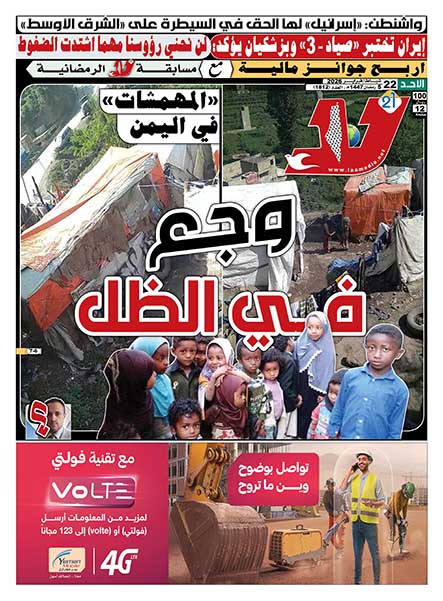



المصدر لا ميديا