
تريتا بارســـي
مجلة فورين بوليسي الأمريكية
ثمة لازمة تتكرر في السياسة الخارجية للولايات المتحدة منذ عقد أو أكثر: أنه من دون الولايات المتحدة، سوف ينحدر الشرق الأوسط إلى دوامة الفوضى -أو حتى ما هو أسوأ، أن إيران ستبعث الإمبراطورية الفارسية وتبتلع المنطقة بأسرها.
ومع ذلك، عندما اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم خوض الحرب مع إيران بعد سلسلة من الهجمات التي نُسبت إلى إيران على المملكة السعودية العام الماضي، وأعلن نيته سحب القوات الأمريكية من المنطقة، لم تكن الفوضى أو الغزو هما اللذان تليا. بدلا من ذلك، كانت دبلوماسية إقليمية ناشئة -خاصة بين إيران والسعودية والإمارات ـ وتراجعٌ للتصعيد هما اللذان جاءا في الأعقاب. ومن المؤكد أنه تمت إعادة توزيع الأوراق مرة أخرى في كانون الثاني (يناير)، عندما أمر ترامب باغتيال قاسم سليماني، أحد أهم الشخصيات العسكرية الإيرانية. وبفضل ترامب، أصبحت المنطقة تتحرك مرة أخرى نحو الصراع، بينما اختفت العلامات المبكرة للتقدم الدبلوماسي التي تحققت خلال الأشهر السابقة.
لذلك، حان الوقت لأن تجيب واشنطن عن سؤال حاسم لطالما تهربت منه منذ زمن طويل: هل منعت الهيمنة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط الأطراف الإقليمية من حل النزاعات بينها سلميا بمفردها؟ وهل كانت بهذه الطريقة عائقا أمام الاستقرار بدلا من أن تكون ضامنا له؟
بعد الغزو السوفياتي لأفغانستان في العام 1979، أعلن الرئيس الأمريكي جيمي كارتر عقيدة جديدة: "أي محاولة تبذلها أي قوة خارجية للسيطرة على منطقة الخليج الفارسي"، كما قال، "سوف تعتبر بمثابة اعتداء على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم صد مثل هذا الهجوم بأي وسيلة ضرورية، بما في ذلك القوة العسكرية". وفي سياق الحرب الباردة، كان منع السوفيات -القوة الخارجية الرئيسية التي كان كارتر قلقا منها- من السيطرة على المنطقة الغنية بالطاقة ينطوي على منطق استراتيجي.
لكن هذا المنطق تغيّر مع مرور الوقت. في الثمانينيات، وسع الرئيس الأمريكي رونالد ريغان العقيدة لتشمل التهديدات التي تتوجه إلى تدفق النفط الناشئ من المنطقة أيضا. ومع تغير السياق الجيوسياسي بشكل أكبر، وجد الرؤساء اللاحقون مزيدا من الطرق لتبرير الوجود العسكري الأمريكي المتنامي في الشرق الأوسط. وتحول ما بدأ كسياسة لمنع الآخرين من فرض الهيمنة على المياه الغنية بالنفط في الخليج الفارسي إلى سياسة لتأكيد الهيمنة الأمريكية في المنطقة من أجل "إنقاذها".
طالما أن حلفاء الولايات المتحدة يفتقرون إلى القدرة أو الكفاءة لتأمين المنطقة، كما ذهب التفكير، لن يكون أمام واشنطن خيار سوى تحمل هذه المسؤولية بنفسها. وكان الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش صريحا بشأن ذلك؛ من دون زيادة في مستويات القوات الأمريكية في العراق، كما ادعى، ستكون هناك فوضى في المنطقة. وقد فاته، بالطبع، مفارقة أن غزوه للعراق كان الحدث المفرد الأكثر زعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط خلال العقود الماضية.
كما كتب الباحثون، هال براندز وستيفن كوك وكينيث بولاك، في التأييد لعقيدة كارتر واستمراره، فقد "وضعت الولايات المتحدة قواعد السلوك الأساسية في المنطقة وتمسكت بها: سوف تقابِل الولايات المتحدة أي جهود للتدخل في التدفق الحر للنفط بالقوة؛ وتدعم حرية الملاحة؛ وتطالب بأن تتخلى القوى الإقليمية عن مساعيها التوسعية ضد الدول الأخرى أو أنها ستواجه عواقب وخيمة؛ وأن تمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل".
يبدو هذا السرد دقيقا بما فيه الكفاية (على الرغم من أن القاعدة الأخيرة في القائمة استثنت دائما "إسرائيل")، لكن القصة تخفي كيف وفرت هذه السياسة لحلفاء الولايات المتحدة غطاء للقيام بأعمالهم الخاصة التي تزعزع الاستقرار إلى حد كبير. وهو إغفال يستخدمه براندز في مقال له في "بلومبيرغ" أيضا، حيث يستشهد بقصة كاتب العمود في "الواشنطن بوست"، جمال خاشقجي، ليجادل بأن "الشرق الأوسط بعد أمريكا لن يكون مستقرا وسلميا. إنه سيكون أكثر شرا واضطرابا مما هو عليه اليوم". وعلى حد تعبير السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام في العام 2018، فإنه "لولا الولايات المتحدة، لكانوا سيتحدثون الفارسية خلال أسبوع تقريبا في الخليج".
كل هذا من دون إشارة إلى حقيقة أن حماية الولايات المتحدة لبعض الحلفاء في المنطقة، إذا كان ثمة شيء، قد مكنت ترويجهم للإرهاب وأنشطتهم المزعزعة للاستقرار، والتي دفعت بدورها إلى مزيد من الرد الإيراني.
لم يثبت أن التأكيدات حول الدور المحوري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بغض النظر عن عدد مرات تكرارها، كانت صحيحة. إن إيران، التي دمرتها العقوبات والفساد وسوء الإدارة الاقتصادية، ليست في أي مكان قريب من تأسيس الهيمنة لنفسها في المنطقة. وتنفق المملكة السعودية على جيشها أكثر من خمسة أضعاف ما تنفقه إيران؛ ويتفوق مجلس التعاون الخليجي مجتمعا -المملكة السعودية والكويت وقطر والبحرين وعمان والإمارات- على إيران في الإنفاق بمقدار ثمانية أضعاف. وفي الوقت نفسه، في حين أن إيران لا تملك أسلحة نووية وما تزال تخضع لعمليات تفتيش أكثر من أي دولة أخرى، فإن لدى "إسرائيل" برنامج أسلحة نووية ليست له أي شفافية دولية على الإطلاق. وربما كانت إيران بارعة في الاستفادة من الإفراط في التمدد الأمريكي والخطوات الأمريكية الخاطئة في العقود القليلة الماضية، لكن تأسيس هيمنة هو مسألة مختلفة تماما.
علاوة على ذلك، لم تقع المنطقة أعمق في الفوضى نتيجة لرفض ترامب في وقت سابق الدخول في حرب مباشرة مع إيران بعد الهجمات التي شنها وكلاء إيران على منشآت النفط السعودية في أيلول (سبتمبر) 2019. وقد نعى المنتقدون قرار الرئيس باعتباره تخليا عن عقيدة كارتر، ووصفوه بأنها كارثة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي وحذروا من أنه قد يدفع المملكة السعودية إلى البحث عن أسلحة نووية.
ولكن، بدلا من ذلك، وإدراكا منهما لواقع أن الجيش الأمريكي لم يعد تحت تصرفهما، بدأت المملكة السعودية والإمارات في الذهاب إلى الخيارات الدبلوماسية التي كانت متاحة دائما. من جانبها، كثفت المملكة السعودية محادثاتها المباشرة مع المتمردين الحوثيين في اليمن كوسيلة لتخفيف التوترات مع راعيتهم، إيران. وانخفض مستوى العنف على كلا الجانبين نتيجة لذلك، وتم إطلاق سراح أكثر من 100 أسير حرب. وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن انخفاض بنسبة 80 في المائة في الغارات الجوية التي تنفذها قوات التحالف، ولم تقع أي وفيات يمنية في الأسبوعين السابقين.
كما اختارت الرياض أيضا تخفيف حدة التوترات مع قطر، الحليف السابق الذي أصبح خصما. ويبدو أن الحكومة السعودية أمرت بتخفيف الانتقادات الموجهة إلى قطر، واستؤنفت بعض الأحداث الرياضية بين البلدين، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
كما قال مسؤولون سعوديون أنهم تواصلوا بهدوء مع إيران عبر وسطاء للبحث عن طرق لتخفيف التوترات. ورحبت طهران، بدورها، بالتدفئة المرتقبة للعلاقات السعودية- القطرية، وطرحت -وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، خطة سلام على أساس تعهد إيراني-سعودي متبادل بعدم الاعتداء.
بل إن تغيرا أكبر طرأ على التوجهات في أبوظبي. ففي تموز (يوليو)، بدأت الإمارات سحب قواتها من اليمن. وفي نفس الشهر، شاركت في محادثات مباشرة مع طهران لمناقشة الأمن البحري -حتى أنها أفرجت عن 700 مليون دولار من أرصدة إيرانية كانت محتجزة لديها، في تناقض مع استراتيجية الضغط الأقصى التي تنتهجها إدارة ترامب.
قد تكون بعض هذه التدابير تكتيكية أكثر من كونها استراتيجية. ربما تكون المملكة السعودية قد قلصت من التوترات مع قطر والحوثيين من أجل وضع نفسها في وضع أفضل في مواجهة مع طهران على الطريق. وربما شعرت دولة الإمارات أيضا بأن هناك ضرورة لتخفيف التوترات.
ومع ذلك، عندما بدا أن الولايات المتحدة مستعدة للتراجع من المنطقة، أصبحت حسابات حلفائها السابقين تميل نحو الدبلوماسية. ولم يكن لدى هؤلاء الحلفاء العرب خيار سوى تغيير طُرقهم لأنه لم يعد بإمكانهم العمل تحت حماية الولايات المتحدة. وإذا كان الاستقرار في الشرق الأوسط هو الهدف الرئيسي للولايات المتحدة، فكان ينبغي لواشنطن أن تحتفل بهذه التطورات بدلا من أن تأسف لها.
في أعقاب إقدام الولايات المتحدة على اغتيال سليماني -الذي وصفه بعض المسؤولين السابقين في الولايات المتحدة بأنه عمل حرب- قد تتغير الحسابات مرة أخرى. فوفقا لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، كان سليماني في العراق ليجلب إليه رد طهران على رسالة من الرياض حول كيفية نزع فتيل التوترات الإقليمية، فيما يُفترض أنه جاء كجزء من اهتمام السعودية المتجدد بالدبلوماسية. وكان العراقيون، حسب قوله، يتوسطون بين الخصمين، وهي مبادرة أصبحت الآن موضع تساؤل.
كما يحتمل كثيرا أن تستنتج إيران، مخطئة أو محقة، أن المملكة السعودية والإمارات تعاونا مع واشنطن في اغتيال سليماني، وهو ما قد لا ينهي الدبلوماسية الأخيرة فحسب، وإنما يدفعها إلى استهداف الرياض وأبوظبي أيضا كجزء من الانتقام لموت سليماني. وهذا أيضا مثال آخر حيث تسببت الأنشطة الأمريكية في المنطقة في قدر من الاضطرابات أكبر من الاستقرار.
ليس هناك بالتأكيد ما كان سيضمن نجاح الجهود الدبلوماسية الأخيرة. ربما لم تكن رياضٌ أكثر مسؤولية ستخلق طهران أكثر مسؤولية أيضا. ولكن، تجدر ملاحظة أن الدبلوماسية لم تكد تبدأ بشكل جدي عندما أظهرت واشنطن بوضوح عدم رغبتها في توريط نفسها في حرب بين المملكة السعودية وإيران. ومن خلال العودة إلى المنطقة في استعراض للقوة العسكرية، قد يثبط ترامب مرة أخرى حلفاء الولايات المتحدة عن أخذ الدبلوماسية على محمل الجد. بل إنهم قد يفسرون مقتل سليماني على أنه ترخيص لاستئناف طرائقهم القديمة.
بعبارات أخرى، كما في الماضي، يبدو أن انحدار الشرق الأوسط إلى الفوضى يكون أكثر احتمالا مع وجود الولايات المتحدة منه من دونها.
23 يناير 2020
مركز (Natourcenter)
للدراسات والأبحاث

.jpg)












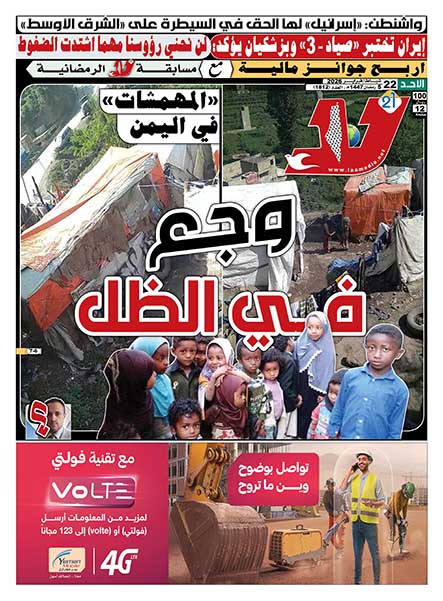



المصدر موقع ( لا ) الإخباري