منشار واحد ومليون خاشقجي
- تم النشر بواسطة «لا» 21 السياسي

«لا» 21 السياسي -
ذبح سلمان وولده 100 رجلٍ وفتى منذ بداية العام 2022 فقط. وفي عدّاد القتل الجماعي في عهد سلمان وحده نفّذت السلطات السعودية ثلاث مجازر وحشية، الأولى في الثاني من كانون الثاني/ يناير 2016 قطعت فيها رؤوس 47 شاباً بينهم 4 قاصرين على الأقل، وكان من بينهم الشيخ المجاهد نمر باقر النمر.
المجزرة الثانية نُفّذت في 23 نيسان/ أبريل 2019، وقُطعت فيها رؤوس 37 شاباً بينهم 6 قاصرين على الأقل.
أحدث المجازر وليس آخرها كانت «مجزرة السبت» 12 آذار/ مارس 2022، وهي الأعلى عدداً، حيث قُطعت رؤوس 81 رجلاً وفتى. ويتخطى هذا العدد إجمالي عمليات الإعدام المعلن تنفيذها خلال عام 2021 والبالغ 67 شخصاً.
ويلفت الكثيرون إلى أن عدد من تم إعدامهم في هذه المرة تجاوز عدد القتلى البالغ 63 شخصاً أعدموا في كانون الثاني/ يناير 1980 عقب استيلاء مجموعة من المسلحين السعوديين على المسجد الحرام واحتجاز مصلين رهائن فيه نحو أسبوعين فيما عرف لاحقاً بحادثة جهيمان.
بالمناسبة، فالرواية الحقيقية للعملية العسكرية التي أنهت حادثة جهيمان ليست تلك التي روجت لها السعودية وأذنابها بالقول إن قوات سعودية قامت بتنفيذ تلك العملية، بل هي قوات فرنسية خاصة مكلفة بأمن الحرمين بموجب اتفاق غير معلن بين الرياض وباريس منذ عقود.
وعودة إلى مجزرة سبت ابن سلمان، الذي يريد -كما هو واضح- أن يحكم السعودية بحدّ السيف كما وأن يشتري صمت العالم إزاء وحشيته بالنفط، لم نشهد إدانات غربية عاجلة وقوية ومستمرة للمذبحة السعودية من قبل العالم «الحر»، الذي عادة ما كان يحتجّ إذا أُعدم رجل واحد في بقعة ما من العالم؛ لكن فقط حين يكون ثمّة توظيف سياسي للاعتراض. وجميعنا يتذكر ما فعله هذا العالم المنافق عند تنفيذ القصاص بحق المتورطين باغتيال الرئيس الشهيد صالح الصماد (رضوان الله عليه).
لم تكن مجزرة الإعدامات الأخيرة توقيتاً وحجماً خارج علاقة التبعية بين السلطة السعودية والأمريكيين وجدلياتها، فالذي حصل أن سلمان وابنه وضمن مساحة تناقضاتهما مع إدارة بايدن، والغرب ككل، وجدا فرصة سانحة لإرسال رسالة هزلية مفادها أننا نستطيع سفك الدماء أصالة عن أنفسنا، وأن سيوفنا لنا ونحن مستقلان في حماية تاريخ حكمنا. وكغيرهما من الملوك والأمراء الجبناء فحماية العروش تكون بجر العُزّل مكبّلين إلى المقاصل والساحات وإعدامهم دون حيلة كما يقول الصحفي موسى السادة، الذي يورد في هكذا سياق حادثة تاريخية ذات دلالة عميقة وواضحة.
أثناء زيارة الملك عبد العزيز للمنطقة الشرقية عام 1939 للاحتفال باكتشاف النفط، قدّم حمد بن عيسى آل خليفة سيفاً للملك السعودي يدعى بـ«الأجرب»، وهو سيف يعود لأحد أجداد عبد العزيز يدعى تركي بن عبد الله، فرفض تسلّمه وقال له: «هذه ذكرى منا لكم، فأبقوه لديكم». بعدها بـ61 عاماً، وتحديداً عام 2010، أرجع آل خليفة السيف للملك عبد الله، وبعد وفاته قدم أبناؤه السيف إلى عمهم الملك الجديد سلمان الذي قام بتسمية كتيبة في الحرس الملكي تحت قيادة ابنه بـ»كتيبة السيف الأجرب».
إن جوهر الأمر يكمن في استيعاب المضمون السياسي والتاريخي لهذا السيف والدماء التي سفكها؛ فبنو سعود وسيفهم «الأجرب» ليسوا مجموعة بشرية مجردة ومستقلة تملّكت سيوفاً فحكمت تاريخ جزء من العرب، بل هيمنوا بأموال النفط على مسار تاريخ الوطن العربي ككل، بل هم جزء من تاريخ غيرهم ضمن علاقة التبعية مع الغرب من البريطانيين في بادئ الأمر والولايات المتحدة اليوم.

.jpg)









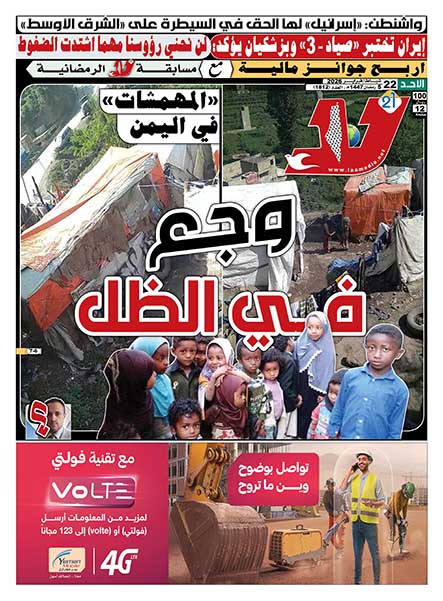





المصدر «لا» 21 السياسي